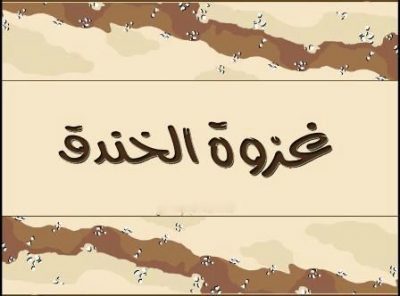بسم الله الرحمن الرحیم
معلومات المقال
العنوان:
يوم الخندق يوم من أيام إبلاغ إمامة أميرالمؤمنين عليه السّلام
خلاصة المقال:
إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قد أبلغ إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه السّلام من أوّل يوم بُعث وأظهر أمره، في مواطن متعدّدة، وبأساليب مختلفة. ومن هذه المواطن الكثيرة: يوم الخندق. يومٌ بارز أميرالمؤمنين عليه السّلام عمرو بن عبدودّ، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله في حقّه ذلك اليوم: «لمبارزة علي بن أبيطالب عليه السّلام لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق، أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة».
وفي هذا المقال نبيّن أوّلاً صحّةَ هذا الحديث النبويّ (بناءً على علوم الحديث عند أهل السنّة وكلمات علمائهم في تراجم الرجال)؛ ثمّ نبيّن دلالة هذا الحديث على إمامة أميرالمؤمنين عليه السّلام بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله.
الكلمات الرئيسيّة:
أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب؛ يوم الخندق؛ أدلّة إمامة علي؛ الأفضليّة؛ عمرو بن عبدودّ.
( 1 )
كلمةٌ حول غزوة الخندق
إنّ غزوة الخندق تعتبر من أهمّ غزوات رسول الله صلّى الله عليه وآله. وقد يعبّر عن هذه الغزوة بالخندق لحفر النبيّ صلّى الله عليه وآله الخندق بإشارة سلمان الفارسي رحمه الله تعالى، وأخرى بالأحزاب لاجتماع طوائف المشركين على حرب المسلمين.
وسمّيت سورة من سور القرآن الكريم باسم هذه الغزوة أعني سورة الأحزاب، بسبب أهميّتها البالغة.
تاريخ غزوة الخندق
اختلفت كلمة أصحاب المغازي في تاريخ غزوة الخندق على قولين:
القول الأوّل: كانت سنة أربع، ذهب إليه:
- محمّد بن شهاب الزّهري (م. 125)؛ نقل عنه ابن مندة الاصبهاني بإسناده إليه، قال:
قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب، وبني قريظة في شوّال سنة أربع.[1]
- موسى بن عقبة (م. 141)؛ نقل عنه البخاري في صحيحه.[2]
- مالك بن أنس (م. 179)؛ نقل عنه أبو زرعة الدمشقي بإسناده إليه، قال:
كانت بدر لسنة ونصف من مقدم رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم المدينة، وأحد بعدها بسنة، والخندق سنة أربع، وبني المصطلق سنة خمس، وخيبر سنة ستّ، والحديبيّة في سنة خيبر، والفتح في سنة ثمان، وقريظة سنة الخندق.[3]
- محمّد بن حبيب البغدادي (م. 245) في كتابه المحبّر قال ضمن غزوات سنة أربع:
ثمّ يوم الخندق، خرج إليه يوم الخميس لعشر خلون من شوّال؛ وانقضى أمره يوم السّبت لليلة خلت من ذي القعدة.[4]
- ابن قتيبة الدينوري (م. 276) في المعارف.[5]
وغيرهم من المتقدّمين والمتأخّرين.
القول الثاني: كانت سنة خمس، ذهب إليه:
- محمّد بن إسحاق المطّلبي (م. 150)؛ نقل عنه ابن هشام في سيرته.[6]
- محمّد بن عمر الواقدي (م. 207)؛ قال في كتابه المغازي:
عسكر رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يوم الثلاثاء لثمان مضت من ذي القعدة، فحاصروه خمس عشرة، وانصرف يوم الأربعاء لسبع بقين سنة خمس.[7]
- محمّد بن جرير الطّبري (م. 310)؛ ذكره في تاريخه في السّنة الخامسة من الهجرة.[8]
وغيرهم من المؤرّخين؛ ولتحقيق القول مجال آخر لا يسعنا في هذا المختصر.
أهداف غزوة الخندق
بالنظر إلى أهداف المشركين، نعرف مدى أهميّة غزوة الخندق، وقيمة مبارزة أمير المؤمنين عليه السّلام … فأقول:
إنّ الوثائق التاريخيّة تشهد بأنّ هدف المشركين هو استأصال رسول الله صلّى الله عليه وآله وقتله على زعمهم. وهم على ثقة من تحقيق هذا الهدف، حتّى جمعوا طوائفهم المختلفة من اليهود وقريش وغطفان، وأرضوا بني قريظة في نقض عهدهم مع المسلمين، وهم حشد هائل لم يسبق له مثيل.
قال اليهود لقريش: إنّا سنكون معكم عليه، حتّى نستأصله.[9]
وقال بعضهم لأبي سفيان: جئنا لنحالفكم على عداوة محمّد وقتاله. قال أبو سفيان: مرحباً وأهلاً، أحبّ النّاس إلينا من أعاننا على عداوة محمّد. قال النفر: فأخرج خمسين رجلاً من بطون قريش كلّها أنت فيهم، وندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حتّى نلصق أكبادنا بها، ثمّ نحلف بالله جميعاً لا يخذل بعضنا بعضاً، ولتكوننّ كلمتنا واحدة على هذا الرجل ما بقي منّا رجل.[10]
وهناك كلام مهمّ لأمير المؤمنين عليه السّلام حول هدف المشركين وما جرى على المسلمين في هذه الغزوة، رواه الشيخ الصّدوق رحمه الله في الخصال، قال عليه السّلام:
إنّ قريشاً والعرب تجمّعت وعقدت بينها عقداً وميثاقاً لا ترجع من وجهها حتّى تقتل رسول الله صلّى الله عليه وآله وتقتلنا معه معاشر بني عبد المطّلب. ثمّ أقبلت بحدّها وحديدها حتّى أناخت علينا بالمدينة واثقة بأنفسها فيما توجّهت له.
فهبط جبرئيل على النبي صلّى الله عليه وآله فأنبأه بذلك، فخندق على نفسه ومن معه من المهاجرين والأنصار، فقدمت قريش فأقامت على الخندق محاصرة لنا ترى في أنفسها القوّة وفينا الضعف؛ ترعد وتبرق ورسول الله صلّى الله عليه وآله يدعوها إلى الله عزّ وجلّ ويناشدها بالقرابة والرحم، فتأبى ولا يزيدها ذلك إلّا عتوّاً.[11]
آيات في القرآن الكريم حول غزوة الخندق
وفي سورة الأحزاب آيات تبيّن أهميّة غزوة الخندق، وتكشف عن أحوال بعض الصّحابة في هذه الغزوة. وحيث لا يسعنا البحث بالتفصيل ـ هنا ـ عن هذه الآيات، نبحث عن بعضها بالإجمال:
قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ ومِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وتَظُنُّونَ بِاللَهِ الظُّنُونَا ! هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَديداً ! وإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ والَّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَهُ ورَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً ! وإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويَسْتَأْذِنُ فَريقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُريدُونَ إِلاَّ فِراراً﴾.[12]
إنّ التأمّل في هذه الآيات الشريفة يبيّن لنا أموراً مهمّة:
منها أهمّيّة هذه الغزوة وقوّة المشركين حتّى خاف المسلمون منهم خيفةً عبّر الله عزّ وجلّ عنها بقوله: ﴿بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ﴾. قال يحيى بن سلام (م. 200) في تفسيره: «﴿وإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ﴾ من شدّة الخوف.»[13]
ومنها الدور السّلبي لبعض الصّحابة …
فبعضٌ منهم ظنّوا بالله تعالى، فإنّ الله عزّ وجلّ أظهر ضمائرهم، وقال: ﴿وتَظُنُّونَ بِاللَهِ الظُّنُونَا﴾. قال مقاتل بن سليمان (م. 150): «يعني الإياس من النصر.»[14]
بل قال بعض: ما وعدنا الله ورسوله إلّا غروراً! كما قال الله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ والَّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَهُ ورَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً …﴾.
وبعض خافوا وقالوا: إنّ بيوتنا عورة. وكشف الله عزّ وجلّ عمّا أرادوا، وقال: ﴿ويَسْتَأْذِنُ فَريقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُريدُونَ إِلاَّ فِراراً﴾.
ونحن نسأل:
مَن هم الذين في قلوبهم مرض؟!
أ ليسوا من الصّحابة؟!
ومن الذين يخافون ويقولون: إنّ بيوتنا عورة. وما يريدون إلّا فراراً؟!
ولا يخفى أنّ بعض الآيات تدلّ على دور إيجابيّ لبعض الصّحابة، كما قال الله سبحانه: ﴿ولَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللّهُ ورَسُولُهُ وصَدَقَ اللّهُ ورَسُولُهُ وما زادَهُمْ إِلاَّ إيماناً وتَسْليماً﴾[15].
ولعلّ بالنظر إلى كتب القوم ووثائق تاريخيّة رويت من طرقهم، تعرف هاتين الطّائفتين من الصّحابة ودورهم في غزوة الخندق …
دور سلمان الفارسي في غزوة الخندق
إنّ سلمان الفارسي رحمه الله تعالى هو من أجلّة أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله، الذي استقام على وصيّته واتّبع أمير المؤمنين عليه السّلام بعده وكان من شيعته؛ وقد مدحه أئمّة أهل البيت عليهم السّلام.
وأمّا في غزوة الخندق، فقد قام بدور أساسي، حيث أشار إلى خطّة دفاعيّة ناجحة؛ لأنّه بعد ما أُخبر رسول الله صلّى الله عليه وآله بأمر المشركين، شاور أصحابه في أمرهم، ووعدهم النّصر إنْ هم صبروا واتّقوا، وأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله. وكان الذي أشار على رسول الله صلّى الله عليه وآله بالخندق سلمان الفارسي رحمه الله.[16]
قال: «يا رسول الله، إنّا إذ كنّا بأرض فارس، وتخوّفنا الخيل خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟»[17]
هذا؛ بالإضافة إلى ما روي في فضله عند حفر الخندق من انتسابه إلى أهل البيت عليهم السّلام. أخرج ابن سعد (م. 230) في الطبقات الكبرى بإسناده عن الصحابي عمرو بن عوف المزني، قال:
«قال المهاجرون: سلمان منّا. وقالت الأنصار: لا بل سلمان منّا. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: سلمان منّا أهل البيت.»[18]
دور أبي بكر في غزوة الخندق
وأمّا أبو بكر، فليس له دور أساسي في هذه الغزوة، كما لم نشاهد له دوراً مهمّاً في أيّة غزوة من غزوات النبيّ صلّى الله عليه وآله … إلّا ما شهدت به الوثائق التاريخيّة من دورٍ سلبيٍّ من خوف وفرار.
وأمّا في غزوة الخندق، فكذلك؛ ما نرى له مبارزةً ولا شجاعةً … بل لقد اعترف بأنّه ممّن كان يخاف على الذراري بالمدينة، وكان يصعد على جبل سلع وينظر إلى بيوت المدينة.
قال أبو بكر:
«لقد خفنا على الذراري بالمدينة من بني قريظة أشدّ من خوفنا من قريش وغطفان، ولقد كنت أوفي على سلع فأنظر إلى بيوت المدينة.»[19]
فما يريد أبو بكر؟! مع أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله بعث سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي في مائتي رجل وزيد بن حارثة في ثلاثمائة، يحرسون المدينة![20]
هذا، بالإضافة إلى أنّه خاف من مبارزة عمرو بن عبد ودّ وما أجابه حين جعل يطلب مبارزاً، وقد ثبت أنّ المسلمين كانوا يومئذ كأنّ على رؤوسهم الطّير لمكان عمرو وشجاعته.[21]
نعم، كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول كلّما يطلب عمرو مبارزاً: «أنا أبارزه يا رسول الله».[22] إلّا أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أمره بالجلوس -وقد وقع ذلك ثلاث مرّات- حتّى يفسح المجال للآخرين ثمّ يتبيّن للأمّة وللتاريخ خوف أصحابه من الموت، لا سيّما من سيدّعي من بعده ما ليس له، ويتبيّن للكلّ أنّ أشجعهم ليس إلّا علي بن أبي طالب، وأنّ الله لا يقيم للإسلام صلباً إلّا بسيّد المسلمين … ولمّا انكشفت هذه الحقيقة التي لم يزل صلّى الله عليه وآله يريد الكشف عنها في سائر المواقف، أعطاه سيفه وعمّمه[23] …
دور عمر بن الخطّاب في غزوة الخندق
وأمّا دور عمر بن الخطّاب في الغزوات والحروب، فقد كان يشبه دور صاحبه، فما نعرف له شجاعة بل كان يفرّ … وأمّا في غزوة الخندق، فنبيّن دوره بالنظر إلى ثلاث قضايا:
الأولى: شجاعة عمر بالسبّ
إنّ عمر بن الخطّاب أظهر شجاعته وبطولته بسبّ الكفّار، لا بمبارزتهم وقتالهم … أخرج ابن خزيمة (م. 311) في صحيحه عن جابر بن عبد الله، قال: «جاء عمر يوم الخندق فجعل يسبّ كفّار قريش.»[24]
أقول:
هل يستوي مَنْ جاهد وبارز المشركين وكشف عن وجه رسول الله صلّى الله عليه وآله، ومَنْ يسبّ الكفّار من وراء الخندق وهو في أمنٍ بسبب شجاعة أمير المؤمنين عليه السّلام؟!
الثانية: عمر وعمرو بن عبد ودّ
وأمّا في قضيّة الخروج للمبارزة، فعمر كصاحبه خاف من مبارزة عمرو بن عبد ودّ … ثمّ بعد مبارزة أمير المؤمنين عليه السّلام لعمرو وقتله، قال عمر بن الخطّاب لأمير المؤمنين عليه السّلام:
هلّا أسلبته درعه؟ فليس للعرب درعاً خيراً [25] منها.[26]
أقول:
اجتمعت الأحزاب على قتل رسول الله صلّى الله عليه وآله واستأصال المسلمين، جاؤوا من فوقهم ومن أسفل منهم، حتّى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، فيخرج أمير المؤمنين لمبارزة فارس قريش … وهذا يطمع في درعٍ! ولا يدري أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أعزّ نفساً وأجلّ قدراً من أنْ يفكّر في الحصول على غنيمة، فإنّه قد أخلص العمل لله إخلاصاً حتّى فضّل عمل واحد من أعماله، من أعمال جميع الأمّة إلى يوم القيامة …
فهل يقاس بأمير المؤمنين عليه السّلام، أحدٌ من هذه الأمّة بعد النّبي؟!
الثالثة: فرار عمر وطلحة
وإنّ لعمر بن الخطّاب دوراً آخر في معركة الخندق … وهو فراره مع بعض الصّحابة كطلحة.
أخرج الطبري (م. 310) في تاريخه بإسناده عن عائشة قالت:
«خرجت يوم الخندق أقفو آثار النّاس، فو الله إنّي لأمشي إذ سمعت وئيد الأرض خلفي ـ تعني حسّ الأرض ـ فالتفتّ، فإذا أنا بسعد، فجلست إلى الأرض، ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس … يحمل مِجَنّه[27]، وعلى سعد درع من حديد قد خرجت أطرافه منها.
قالت: وكان من أعظم النّاس وأطولهم.
قالت: فأنا أ تخوّف على أطراف سعد، فمرّ بي يرتجز، ويقول:
لبّث قليلاً يدرك الهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل
قالت: فلمّا جاوزني قمت، فاقتحمت حديقة فيها نفر من المسلمين، فيهم عمر بن الخطّاب وفيهم رجل عليه تسبغة له لا ترى إلّا عيناه.
فقال عمر: إنّكِ لجريئة، ما جاء بك؟ ما يدريكِ لعلّه يكون تحوّز أو بلاء!.
فو الله ما زال يلومني حتّى وددت أنّ الأرض تنشقّ لي فأدخل فيها، فكشف الرجل التسبغة عن وجهه، فإذا هو طلحة، فقال: إنّكَ قد أكثرت، أين الفرار؟! وأين التحوّز إلّا إلى الله عزّ وجلّ؟!»[28]
أقول:
وقد صرّح طلحة بما أراد عمر، وتضايق من جهر عمر بالفرار أمام عائشة، فاعتبره فراراً إلى الله!
ولا يخفى أنّ هذه الرواية تشهد على عائشة نفسها أيضاً حيث خرجت بلا إذن من رسول الله صلّى الله عليه وآله، فإنّها لو خرجت بإذنه صلّى الله عليه وآله لأجابت عمر وما وددت أنّ الأرض تنشقّ لها فتدخل فيها!
كلمة بترجمة عمرو بن عبدودّ
كان عمرو بن عبد ودّ من فرسان وشجعان قريش، ومن مشاهير الأبطال، يعدّ بألف رجل. تشهد بذلك وثائق من كتب أعلام القوم:
قال أبو جعفر محمّد بن حبيب البغدادي (م. 245):
«فُرْسان قريش: حمزة بن عبد المطّلب، والزبير بن العوّام ابن خويلد، وهبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وخالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وعكرمة بن أبي جهل بن هشام ابن المغيرة. وعمرو فارس يليل ابن عبد ودّ بن أبي قيس من بني عامر بن لؤي كان فارس قريش، قتله علي بن أبي طالب عليه السّلام يوم الخندق.»[29]
وقال الدياربكري (م. 966) في تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس:
«كان عمرو بن عبدودّ من مشاهير الأبطال، وشجعان العرب، وكانوا يعدلونه بألف رجل.»[30]
وعمرو بن عبد ودّ، هو صاحب سيف «المِلَدّ»، قال عمرو[31]:
| إنّ المِلَدّ لَسَيْفٌ مَا ضَرَبْت بِه كَمْ مِنْ كَبِيرٍ سَقاهُ الْمَوْت ضَاخية |
يَوْماً مِنَ الدَّهْرَ إِلّا حَزَّ أَوْ كَسرا ويَافِع قطّ لَمْ يدركْ بِهِ كِبَرا |
وهو الذي كان على ميسرة المشركين يوم بدر[32]، وجُرح في هذه الغزوة، وبسببها لم يشهد أحداً.
قال محمّد بن إسحاق (م. 150):
«كان عمرو بن عبد ودّ قد قاتل يوم بدر حتّى أثبتته الجراحة، فلم يشهد يوم أحد، فلمّا كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مكانه.»[33]
وقد ذكره بما تقدّم غير واحد من الحفّاظ، منهم:
أبو جعفر الطبري (م. 310) في تاريخه[34]، والحاكم النيسابوري (م. 405) في المستدرك على الصحيحين[35]، أبو إسحاق الثعلبي (م. 427) في الكشف والبيان عن تفسير القرآن[36]، وابن عبد البرّ (م. 463) في الدرر في اختصار المغازي والسير؛[37] وغيرهم ممّن يطول الكلام بذكر أسمائهم.
وقتل عمرو بن عبد ودّ يوم بدر: سعد بن خيثمة بن الحارث[38]، وعمير بن أبي وقّاص أخا سعد.[39]
وأمّا يوم الخندق، فقطع عمرو الخندق وهو يقول: “لا أنصرف حتّى أقتل محمّداً”.[40] وكان يطلب مبارزاً ويقول[41]:
| ولَقَدْ بَحِحْتُ مِنَ النّدَاء ووَقَفْتُ إِذْ جَبُنَ الشُّجاع وكَذَاكَ أَنّي لَمْ أَزَل إِنَّ الشَّجَاعَةَ فِي الْفَتَى |
بِجَمْعِكُمْ هَلْ مِنْ مُبَارِز لَمَوْقِف الْبَطَلِ المُنَاجِز مُتَسَرّعاً نَحْوَ الْهَزَاهِز والجْوُدَ مِنْ خَيْرِ الغَرَائِز |
وكأنّ الطير على رؤوس أبطال الأصحاب فضلاً عن منهزمي الحروب.
ولكن أجابه أمير المؤمنين عليه السّلام في كلّ مرّةٍ ويأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله بالجلوس[42] كما مرّ.
وقد نسب إليه عليه السّلام، أنّه قال لعمرو[43]:
| لَا تَعْجَلَنَّ فَقَدْ أَتَاك ذُو نِيَّةٍ وبَصِيرَةٍ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيم مِنْ ضَرْبَةٍ فَوْهَاء يَبْقَى ولَقَدْ دَعَوْت إِلى الْبِرَاز |
مُجِيبُ صَوْتِكَ غَيْرُ عَاجِز والصِّدْقُ مَنْجَى كُلِّ فَائِز عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِز أَثَرُها عِنْدَ الْهَزَاهِز فَمَا تُجِيِبُ إِلى الْمُبَارِز |
ثمّ تبارزا حتّى قتله أميرالمؤمنين عليه السّلام، وبسببه خرجوا منهزمين كما قال ابن إسحاق.[44]
وإليك نصّ ما قال الواقدي (م. 207) حول هذه القضيّة، وفي كلامه شواهد على ما ذكرنا وفوائد أخر:
«إنّ رؤساءهم أجمعوا أن يغدوا جميعاً، فغدا أبو سفيان بن حرب، وعكرمة بن أبي جهل، وضرار بن الخطّاب، وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وهبيرة بن أبي وهب، ونوفل بن عبد الله المخزومي، وعمرو بن عبد ودّ، ونوفل بن معاوية الديلي في عدّة، فجعلوا يطيفون بالخندق، ومعه رؤساء غطفان: عيينة بن حصن، ومسعود بن رخيلة، والحارث بن عوف؛ ومن سليم رؤساؤهم، ومن بني أسد طليحة بن خويلد.
وتركوا الرجال منهم خلوفاً، يطلبون مضيقاً يريدون يقتحمون خيلهم إلى النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم وأصحابه، فانتهوا إلى مكان قد أغفله المسلمون، فجعلوا يكرهون خيلهم ويقولون: هذه المكيدة ما كانت العرب تصنعها ولا تكيدها. قالوا: إنّ معه رجلاً فارسياً، فهو الذي أشار عليهم بهذا.
قالوا: فمن هناك إذاً؛ فعبر عكرمة بن أبي جهل، ونوفل ابن عبد الله، وضرار بن الخطّاب، وهبيرة بن أبي وهب، وعمرو بن عبد ودّ، وقام سائر المشركين من وراء الخندق لا يعبرون، وقيل لأبي سفيان: ألا تعبر؟ قال: قد عبرتم، فإن احتجتم إلينا عبرنا.
فجعل عمرو بن عبد ودّ يدعو إلى البراز ويقول:
| ولَقَدْ بَحِحْتُ مِنَ النّدَاء | لجَمْعِكُمْ هَلْ مِنْ مُبَارِز |
وعمرو يومئذ ثائر، قد شهد بدراً فارتثّ جريحاً فلم يشهد أحداً، وحرم الدّهن حتّى يثأر من محمّد وأصحابه، وهو يومئذ كبير يقال بلغ تسعين سنة.
فلمّا دعا إلى البراز قال علي عليه السّلام: أنا أبارزه يا رسول الله؛ ثلاث مرّات.
وإنّ المسلمين يومئذ كأنّ على رؤوسهم الطّير، لمكان عمرو وشجاعته.
فأعطاه رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم سيفه وعمّمه وقال: اللّهمّ أعنه عليه.»[45]
وعدّه الصّحابي نعيم بن مسعود رأس قريش، حيث قال لبني قريظة في كلام له: «قتل رأسهم عمرو بن عبد ودّ».[46]
وقد افتخر المسلمون بقتله حتّى أنشأ الشّعراء يفتخرون به.[47]
قال حسّان بن ثابت يفتخر بقتل عمرو[48]:
| بَقِيَّتُكُمْ عَمْرو أَبَحْناهُ بِالْقَنا ونَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ بِكُلّ مُهَنَّد ونَحْنُ قَتَلْناكُمْ بِبَدْرٍ فَأَصْبَحَت |
بِيَثْرِبَ نَحْمِي والحُمَاةُ قَلِيل ونَحْنُ وُلاةُ الحَرْبِ حِينَ نَصُول مَعَاشِرُكُمْ فِي الْهَالِكِينَ تَجُول |
هذا؛ وإليك الكلام في قول رسول الله صلّى الله عليه وآله:
«لمبارزة عليّ بن أبي طالب عليه السّلام لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة». ثمّ تصحيح إسناده من طرق العامّة.
وبيان دلالته على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام بلافصلٍ.
( 2 )
اتّفاق الفريقين على رواية الحديث
لقد اتّفق الفريقان -الشيعة والسنّة- على رواية هذا الحديث؛ أعني خبر أفضليّة مبارزة أميرالمؤمنين عليه السّلام لعمرو بن عبد ودّ من أعمال جميع الأمّة إلى يوم القيامة.
ومتى اتّفق الطرفان على رواية حديث وقبوله مع اختلافهما في كثير من القواعد والأسس في قبول الأخبار وثبوت الوقائع التاريخيّة … كشف ذلك عن ثبوته بلا ريب، واعتباره عند الجميع وأنّه لا مناص لأحدٍ عن قبوله والإذعان به.
رواية الشيعة
إنّ قضيّة مبارزة أميرالمؤمنين عليه السّلام لعمرو بن عبد ودّ فارس يَلْيَل، رويت في كثير من كتب أصحابنا الإماميّة أعلى الله مقامهم الحديثية والتاريخيّة والكلاميّة.
وقد روي عن الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام في قوله تعالى: ﴿وكَفَى اللَهُ المُؤْمِنينَ الْقِتال﴾[49] قال: «بعليّ بن أبي طالب عليه السّلام وقتله عمرو بن عبد ودّ.»[50]
وذكر أصحابنا رحمهم الله تعالى في كتبهم تفصيل قتال يوم الأحزاب ومبارزة أمير المؤمنين عليه السّلام؛ ونظمه الشعراء في أشعارهم، ولا بأس بذكر بعض الأشعار حول هذه القضيّة.
نسب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال بعد مبارزته وقتله عمرو بن عبد ودّ[51]:
| ضَرَبْتُه بالسّيفِ فَوْق الهَامَة أَنَا عَليٌ صَاحِبُ الصّمَصْامَة أَخُو رَسُولِ اللهِ ذِي العَلامَةِ |
بِضَرْبَةٍ صَارِمَةٍ هَدّامَةٍ وصَاحِبُ الْحَوْضِ لَدَى القِيَامَةِ قَدْ قَالَ إِذْ عَمَّمَني عَمَامَة |
أَنْتَ الذي بَعْدِي لَهُ الإِمَامَةُ
وقال ابن الحجّاج البغدادي (م. 391):
| فَدَيْتُ فَتًى دَعَاهُ جَبْرَئِيل وعَمْرو قَدْ سَقَاهُ الموْتَ صرفاً دَعَا أَنْ لَا فَتَى إِلَّا عَلِي |
وهُمْ بَيْنَ الخَنَادِقِ فِي انْحِصَار ذُبَابُ السَّيْفِ مَشْحُوذ الغِرَار وأَنْ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَار |
وأمّا خبر أفضليّة مبارزته من أعمال جميع الأمّة أو عبادة الثقلين، فروي أيضاً -مرفوعاً وموقوفاً- في كثيرٍ من كتب أصحابنا الإماميّة، وكذا في كتب غيرهم من فرق الشيعة.[52]
ولنكتف هنا بما روى المحدّث الجليل الشيخ الصّدوق (م. 381) أعلى الله مقامه الشّريف في كتابه الخصال، في خبر طويل بإسناده عن مكحول، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال:
«لقد علم المستحفظون من أصحاب النبيّ محمّد صلّى الله عليه وآله أنّه ليس فيهم رجلٌ له منقبةٌ إلّا وقد شركته فيها وفضلته، ولي سبعون منقبة لم يشركني فيها أحدٌ منهم …
وأمّا الستّون، فإنّي قتلت عمرو بن عبد ودّ وكان يعدّ بألف رجلٍ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله في حقّي:
لضربة عليّ يوم الخندق أفضل من أعمال الثّقلين.
وقال:
برز الإسلام كلّه إلى الكفر كلّه.»[53]
رواية أهل السنّة
لا يخفى أنّ خبر قضيّة يوم الأحزاب ومبارزة أميرالمؤمنين عليه السّلام لعمرو بن عبد ودّ، متواتر عند أهل السنّة. قد رواه أعلام القوم وأصحاب السّير والمغازي كالشافعي (م. 207) في الأم[54]، وابن هشام (م. 213) في السيرة النبويّة[55]، وابن سعد (م. 230) في الطبقات الكبرى[56]، وغيرهم ممّن يطول المقام بذكر أسمائهم.
وقد أخرج الحافظ ابن عساكر الدمشقي (م. 571) في كتابه تاريخ مدينة دمشق، بإسناده عن عبد الله بن مسعود: أنّه كان يقرأ ﴿وكَفَى اللَهُ المُؤْمِنينَ الْقِتال﴾[57] بعليّ بن أبي طالب.[58]
ومن راجع الكتب المعتمدة للعامّة، ونظر في أخبار غزوة الخندق؛ لوجد كثيراً من فضائل أميرالمؤمنين عليه السّلام كما في غيرها من الحروب والغزوات … ولولا أنّ التعرّض لها يخرجنا عن صلب الموضوع ولا يسع هذا المختصر لذلك، لبحثنا عنها.
وأمّا خبر أفضليّة مبارزته عليه السّلام من أعمال جميع الأمّة إلى يوم القيامة، فقد روي في كثير من كتب أهل السنّة الحديثيّة والتاريخيّة والكلاميّة، وأُخرج بأسانيد مختلفة وألفاظ متفاوتة؛ فنقدّم قائمةً بأسماء بعض مَن رواه ونصوص رواياتهم، وستقف على الآخرين في مطاوي هذا المقال.
1 . الحاكم النيسابوري (م. 405)
رواه الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصّحيحين بإسناده عن الصّحابي معاوية بن حَيْدة القشيري، مرفوعاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله؛ قال:
«حدّثنا لؤلؤ بن عبد الله المقتدري في قصر الخليفة ببغداد، ثنا أبو الطيّب أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهّاب المصري بدمشق، ثنا أحمد بن عيسى الخشّاب بتنّيس، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا سفيان الثوري، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم:
لمبارزة عليّ بن أبي طالب [عليه السّلام] لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة.»[59]
2 . أبو بكر الخطيب البغدادي (م. 463)
رواه الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، بإسناده عن رسول الله صلّى الله عليه وآله، قال:
«أخبرنا الطاهري[60]، حدّثنا لؤلؤ بن عبد الله القيصري، حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد النصيبي الصوفي بالموصل، حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن شدّاد، قال: حدّثني محمّد بن سنان الحنظلي، حدّثني إسحاق بن بشر القرشي، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أنّه قال:
لمبارزة علي بن أبي طالب [عليه السّلام] لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة.»[61]
3. عبيد الله بن عبد الله الحسكاني (م. 490)
أخرجه المحدّث الحسكاني[62] في كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن رسول الله صلّى الله عليه وآله:
«أخبرنا أبو سعد السعدي قراءة عليه غير مرّة، قال: حدّثنا أبو محمّد لؤلؤ بن عبد الله القيصري ببغداد سنة سبع وستّين، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد النصيبي، قال: حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن شدّاد بالعسكر، قال: حدّثني محمّد بن سنان الحنظلي، قال: حدّثني إسحاق بن بشر القرشي، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أنّه قال:
لمبارزة عليّ بن أبي طالب [عليه السلام] لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة.»[63]
4 . شيرويه بن شهردار (م. 509)
أورده الحافظ أبو شجاع شيرويه بن شهردار مؤرخ همذان[64]، في كتابه الفردوس بمأثور الخطاب، وقال:
«معاوية بن حيدة:
لمبارزة علي بن أبي طالب [عليه السلام] لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة.»[65]
5 . الموفّق الخوارزمي (م. 568)
أخرجه الموفّق بن أحمد الخوارزمي في كتابه مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقال:
«أخبرنا الإمام الحافظ أبو الفتح عبد الواحد بن الحسن الباقرجي، أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد الجويني، قال: قرأت على أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، أخبرنا عبد الرحمان بن حمدان السعدي، قال:
حدّثني لؤلؤ القصيري، حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن خضر الصوفي، حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن شداد ، حدّثني محمّد بن سنان الحنظلي، حدّثنا إسحاق ابن بشر القرشي، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه:
عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال:
لمبارزة عليّ بن أبي طالب لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق، أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة.»[66]
6 . إبراهيم بن محمّد الجويني (م. 722)
أخرجه الجويني في كتابه فرائد السّمطين في فضائل المرتضى والبتول والسّبطين، وقال:
«أنبأني شيخنا أبو عمرو عثمان بن الموفق رحمه الله، عن المؤيد بن محمّد المقرئ إذناً، عن عبد الجبّار بن محمّد الخواري، قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري المفسّر رحمه الله، قال: أنبأنا عبد الرّحمن بن حمدان السعدي، حدّثنا لؤلؤ القصري، حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن خضر الصوفي بالموصل، حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن شدّاد، حدّثني محمّد بن سنان الحنظلي، حدّثنا إسحاق بن بشر القرشي، عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جدّه:
عن النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قال:
لمبارزة عليّ بن أبي طالب عليه السّلام لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة.»[67]
7 . سراج الدين ابن الملقّن (م. 804)
أورده سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقّن، في كتابه البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، وقال:
«الحديث الثاني بعد الأربعين:
قال الرافعي[68]: وروي أنّ عليّاً كرّم الله وجهه بارز يوم الخندق عمرو بن عبد ودّ.
هو كما قال، وقد ذكره الإمام الشافعي هكذا، وأسنده الحاكم من حديث ابن عبّاس ثمّ قال: هذا حديث صحيح الإسناد.
وروى البيهقي بإسناده إلى ابن إسحاق، قال:
خرج – يعني يوم الخندق – عمرو بن عبد ودّ فنادى: من يبارز؟
فقام عليّ رضي الله عنه وهو مقنع في الحديد، فقال: أنا لها يا نبي الله.
فقال: إنّه عمرو، اجلس.
فنادى عمرو: ألا رجل وهو يؤنبهم ويقول: أين جنّتكم التي تزعمون أنّه من قتل منكم دخلها، أفلا يبرز إليّ رجلٌ؟
فقام علي رضي الله عنه، فقال: أنا يا رسول الله.
فقال: اجلس.
فنادى الثالثة وذكر شعراً، فقام علي [عليه السّلام] فقال: أنا يا رسول الله.
فقال: إنّه عمرو.
قال: وإن كان عمراً.
فأذن له رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فمشى إليه حتّى أتاه وذكر شعراً. فقال له عمرو: من أنت؟
فقال: أنا عليٌ.
قال: ابن عبد مناف؟
فقال: أنا علي بن أبي طالب.
فقال: غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسنّ منك، فإنّي أكره أن أهريق دمك.
فقال علي رضي الله عنه: لكنّي والله ما أكره أن أهريق دمك. فغضب ونزل وسلّ سيفه كأنّه شعلة نار، ثمّ أقبل نحو علي رضي الله عنه مغضباً، واستقبله علي رضي الله عنه بدرقته[69]، فضربه عمرو في الدرقة فقدّها وأثبت فيها السّيف، وأصاب رأسه فشجّه، وضربه عليّ كرّم الله وجهه على حبل العاتق فسقط، وثار العجاج، وسمع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم التكبير، فعرف أن عليّاً رضي الله عنه قتله.
وفي مستدرك الحاكم من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً:
لمبارزة عليّ لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة.»[70]
8 . ابن حجر العسقلاني (م. 852)
أورده أبو الفضل ابن حجر العسقلاني في كتابه إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة من طريق الحاكم، قال:
«حديث (كم):
لمبارزة علي بن أبي طالب [عليه السلام] لعمرو بن ودّ يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة.»[71]
9 . جلال الدين السيوطي (م. 911)
أورده جلال الدين السيوطي في كتابه جامع الأحاديث، من طريق الحاكم، وقال:
«لمبارزة علي بن أبي طالب [عليه السلام] لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة.
(ك) وتعقّب عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه. قال الذهبى: صحّ.»[72]
10. المتقي الهندي (م. 975)
أورده المتّقي الهندي في كتابه كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، من طريق الحاكم وقال:
«لمبارزة علي [عليه السلام] لعمرو بن عبد ودّ أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة.
ك وتعقّب عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه. قال الذهبي: قبّح الله رافضياً افتراه!»[73]
11 . علي بن إبراهيم الحلبي (م. 1044)
أورده علي بن إبراهيم الحلبي في كتابه إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون المشهور بـ السيرة الحلبيّة، وقال:
«في روايةٍ أنّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أعطاه سيفه ذا الفقار، وألبسه درعه الحديد وعمّمه بعمامته. وقال:
اللّهمّ أعنه عليه، أي وفي لفظ: اللّهمّ هذا أخي وابن عمّي، فلا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين.
زاد في رواية: أنّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم رفع عمامته إلى السّماء، وقال:
إلهي أخذت عبيدة منّي يوم بدر، وحمزة يوم أحد، وهذا عليّ أخي وابن عمّي؛ الحديث. فمشى إليه علي كرّم الله وجهه …
[وذكر تفصيل المبارزة إلى أن قال]:
ذكر بعضهم أنّ النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم عند ذلك قال:
قتل عليّ لعمرو بن عبدودّ أفضل من عبادة الثّقلين.
قال الإمام أبو العبّاس ابن تيميّة: وهذا من الأحاديث الموضوعة التي لم ترد في شيء من الكتب التي يعتمد عليها ولا بسند ضعيف؛ وكيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الثّقلين الإنس والجنّ ومنهم الأنبياء.
قال: بل إنّ عمرو بن عبدودّ هذا لم يعرف له ذكر إلّا في هذه الغزوة.
أقول: ويردّ قوله إنّ عمرو بن عبدودّ هذا لم يعرف له ذكر إلّا في هذه الغزوة قول الأصل. وكان عمرو بن عبدودّ قد قاتل يوم بدر حتّى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد، فلمّا كان يوم الخندق خرج معلماً أي جعل له علامة يعرف بها ليرى مكانه، أي ويردّه أيضاً ما تقدّم من أنّه نذر أن لا يمسّ رأسه دهناً حتّى يقتل محمّداً صلّى الله عليه [وآله] وسلّم.
واستدلاله بقوله: وكيف يكون إلى آخره، فيه نظر لأنّ قتل هذا كان فيه نصرة للدين وخذلان للكافرين.
وفي تفسير الفخر أنّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قال لعليّ كرم الله وجهه بعد قتله لعمرو بن عبد ودّ:
كيف وجدت نفسك معه يا علي؟.
قال: وجدته لو كان أهل المدينة كلّهم في جانب وأنا في جانب لقدرت عليهم.»[74]
12 . عبد الحقّ الدهلوي (م. 1052)
أورد الشيخ عبد الحقّ الدهلوي الحنفي، هذا الحديث في كتابه تجهيز الجيش، وقال:
«قال النبي عليه السّلام يوم الأحزاب:
لضربة علي خير من عبادة الثقلين.»[75]
13 . سليمان القندوزي (م. 1270)
أورده القندوزي في كتابه ينابيع المودة، وقال:
«وفي المناقب: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم:
ضربة علي يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة.»[76]
وقد عرفت إلى هنا أنّ هذا الحديث متّفق على روايته عند الفريقين؛ ولا يخفى أنّ ما أوردناه ليس كلّ ما روي في هذا الباب، كما ستعرف بعضها الآخر في مطاوي هذا المقال.
( 3 )
النظر في إسناد الحديث
إنّ الأصل في الحكم على حديث والتعرّف على مدى صحّته، هو النظر في إسناده. وهذا الحديث -كما عرفت- روي بأسانيد مختلفة، ونحن نختار هنا أقدم النّصوص المرفوعة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله، وهو رواية الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصّحيحين؛ فإنّه قال:
«حدّثنا لؤلؤ بن عبد الله المقتدري في قصر الخليفة ببغداد، ثنا أبو الطيّب أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهّاب المصري بدمشق، ثنا أحمد بن عيسى الخشّاب بتنّيس، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا سفيان الثوري، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم:
لمبارزة عليّ بن أبي طالب [عليه السلام] لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة.»[77]
وإليك الكلام في ترجمة الحاكم النيسابوري بالإختصار أوّلاً ثمّ ترجمة رواة هذا الإسناد والبحث عنهم ثانياً.
ترجمة الحاكم النيسابوري
هو: أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد بن حمدويه الضبّي، الطهماني، النيسابوري.
إمام أهل الحديث في عصره، وقد أثنى علماء القوم عليه:
قال أبو يعلی الخليلي (م. 446):
«عالم عارف واسع العلم، ذو تصانيف كثيرة، لم أر أوفى منه … ذاكر الحفّاظ والشّيوخ، وكتب عنهم أيضاً، وناظر الدارقطني فرَضيه.
وهو ثقة واسع العلم، بلغت تصانيفه الكتب الطوال والأبواب، وجمع الشيوخ المكثرين والمقلّين قريباً من خمسمائة جزء … رأيته في كلّ ما ألقي عليه بحراً لا يعجزه عنه.»[78]
وقال الخطيب البغدادي (م. 463):
«كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ، وله في علوم الحديث مصنّفات عدّة.»[79]
وقال عبد الغافر بن إسماعيل النيسابوري (م. 529):
«إمام أهل الحديث في عصره والعارف به حقّ معرفته، يقال له الضبّي، لأنّ جدّ جدّته عيسى بن عبد الرحمن بن سليمان الضبّي، وأمّ عيسى بن عبد الرحمن متويه بنت إبراهيم بن طهمان الزاهد الفقيه فلذلك يقال له الطهماني؛ وبيته بيت الصلاح والورع والتاذين …
واختصّ بصحبة إمام وقته أبي بكر محمّد بن إسحاق بن أيّوب الصبغي، فكان في الخواصّ عنده والمرموقين، وكان يراجعه في السؤال عن الجرح والتعديل وعلل الحديث ويقدّمه على أقرانه.
وأدّى اختصاصه به واعتماده إليه في أمور مدرسة دار السنة وفوّض إليه تولية أوقافه، واستضاء برأيه في أموره اعتماداً على حسن ديانته ووفور أمانته.
وجرت له مذاكرات ومحاورات مع الحفّاظ والأئمّة من أهل الحديث مثل أبي بكر ابن الجعابي بالعراق، وأبي علي الحافظ الماسرجسي الذي كان أحفظ زمانه.
وأخذ في التصنيف سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، فاتّفق له من التصانيف ما لعلّه يبلغ قريباً من ألف جزء من تخريج الصحيحين والعلل والتراجم والأبواب والشيوخ … ومضى إلى رحمة الله ولم يخلّف في وقته مثله.»[80]
وقد عرفت من هذه الكلمات أنّه -عند أهل السنّة- رجلٌ ثقةٌ، حافظٌ، عالمٌ بعلوم الحديث، مَهَر الحديث حيث سمع من شيوخ كثيرة … وحاور علماء عصره … وذاكر أعلام الفنّ، حتّى ناظر الدارقطني فرضيه، وصارت كتبه مرجعاً في الحديث وعلومه.
ترجمة لؤلؤ بن عبد الله المقتدري
هو أبو محمّد لؤلؤ بن عبد الله المقتدري مولى المقتدر بالله.
سمع بدمشق عبد الله بن محمّد بن الحسن بن جمعة، والحسن بن حبيب، وهشام بن أحمد بن عبد الله بن كثير الدمشقيين، وقاسم بن إبراهيم الملطي، وإبراهيم بن محمّد النصيبي الصوفي، وأحمد بن إبراهيم بن غالب البلدي، وأحمد بن إبراهيم بن عبد الوهّاب المصري.[81]
روى عنه الحاكم النيسابوري كما يدلّ عليه قوله: “حدّثنا”. وأبو الحسن عليّ بن أبي حامد الجرجاني، وأبو بكر البرقاني، وعلي بن عبد العزيز الطاهري، والقاضي أبو العلاء محمّد بن علي الواسطي، ومحمّد بن عمر بن بكير المقرئ.[82]
وروى الخطيب البغدادي عنه بواسطة عليّ بن عبد العزيز الطاهري، وأبي بكر البرقاني، والقاضي أبي العلاء الواسطي، ومحمّد ابن عمر بن بكير المقرئ.[83]
قال الخطيب البغدادي (م. 463):
«ولم أسمع أحداً من شيوخنا يذكره إلّا بالجميل.»[84]
ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهّاب
هو: أبو الطيّب أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهّاب الشّيباني الدّمشقي، المعروف بابن عبادل.
مات في رجب سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، وكان في عشر التّسعين.[85]
سمع بحر بن نصر الخولاني، وإبراهيم بن منقذ، والعبّاس بن الوليد العذري، وأبا أميّة الطرسوسي، وخلقاً كثيراً.[86]
وسمع عنه الطبرانيّ، وأبو هاشم المؤدّب، وأبو بكر بن أبي الحديد، وعبد الوهّاب الكلابي، وآخرون.[87]
وأمّا اتّصال السند في هذه الطبقة، فظاهر من نفس ألفاظ الأداء.
قال ابن عساكر (م. 571):
«كانوا أهل بيت علم، وكان فيهم جماعة محدّثين.»[88]
وقال شمس الدين الذهبي (م. 748):
«أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب … وثّق.»[89]
ترجمة أحمد بن عيسى الخشّاب
هو: أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي، الخشّاب، التنّيسي.
سمع عمرو بن أبي سلمة وعبد الله بن يوسف.[90]
وروى عنه عبد الله بن محمّد بن المنهال، وعيسى بن أحمد الصّوفي، وموسى بن العبّاس، وجماعة.[91]
مات بتنّيس سنة ثلاث وسبعين ومائتين.[92]
وأمّا بعض المتعصّبين، فاعتلّ الحديث من جهة أحمد ابن عيسى الخشّاب، فنذكر ما قيل في جرحه ونبحث عنه بالتفصيل، حتّى نحكم على الرواية بالإستناد إلى الأدلّة ونبيّن وهمه في تعليله:
قال ابن يونس المصري (م. 347):
«كان مضطرب الحديث جدّاً.»[93]
وقال ابن حبّان (م. 354):
«يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير، وعن المشاهير الأشياء المقلوبة، لا يجوز عندي الاحتجاج بما انفرد به من الأخبار.»[94]
وقال ابن عدي (م. 365):
«ذكر عنه غير حديث لا يحدّث به غيره عن عمرو بن أبي سلمة وغيره.
… حدّثنا عيسى بن أحمد الصدفي وغيره، قالوا: حدّثنا أحمد بن عيسى الخشّاب، قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف، حدّثنا إسماعيل بن عيّاش، عن ثور بن يزيد، عن خالد ابن معدان، عن واثلة بن الأسقع، أنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قال:
الأمناء عند الله ثلاثة: جبريل وأنا ومعاوية.
قال الشيخ: وهذا الحديث باطلٌ بهذا الإسناد وبغير هذا الإسناد.»[95]
وقال أبو عبد الرّحمن السلمي (م. 412):
«سألته [أي الدارقطني] عن أحمد بن عيسى التنيسي؟ فقال: ليس بالقوي.»[96]
وقال ابن الجوزي (م. 597):
«قال محمّد بن طاهر: أحمد بن عيسى كذّاب يضع الحديث.»[97]
وهذه ملاحظات حول هذه الأقوال:
- إنّ تضعيف أحمد بن عيسى لا يوجب طرح أخباره رأساً والحكم عليها بالوضع والضّعف مطلقاً، لأنّ ألفاظ جرحه ليست إلّا في المرتبة الوسطى من مراتب الضّعف.
لأنّ اضطراب الحديث -وإن كان من ألفاظ الجرح- إلّا أنّه لا يوجب إلّا التثبّت في حديثه؛ على أنّ اتّفاق الفريقين على هذا الحديث، ومتابعة غيره له -كما ستعرف- ينفي هذا الجرح.
وأمّا ابن حبّان المتشدّد في جرح الرواة، فلا يجوّز الاحتجاج إذا انفرد بحديث، وأمّا إذا توبع في حديثه فيحتجّ به. وبه يشعر كلام ابن عدي أيضاً حيث قال: “… لا يحدّث به غيره”.
وأمّا الدارقطني فما كذّبه ولا اتّهمه بالوضع، بل قال: “ليس بالقوي” وما قال: “ليس بقوي”. وعلينا أن نحقّق مرتبة هذا الجرح، ولا نسرع في الحكم كما قال شمس الدين الذهبي:
«وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي. واحتجّ به. وهذا النسائي قد قال في عدّة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه. قال: “قولنا: (ليس بالقوي) ليس بجرح مفسد”.
والكلام في الرّواة يحتاج إلى ورعٍ تامٍّ، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثمّ نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة.
ثمّ أهمّ من ذلك، أن نعلم بالاستقراء التامّ عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة.»[98]
أقول:
وأمّا الإستقراء في ألفاظ الدارقطني والبحث عنها، فلا يسع في هذا المختصر، إلّا أنّا نكتفي بما قال أبو إسحاق الجعبري (م. 732) في كتابه رسوم التحديث في علوم الحديث، قال:
«والجرح: الدارقطني: لين الحديث، ثمّ ليس بالقوي، ثمّ ضعيف فينظر؛ وأمّا متروك، ذاهب، فاسق، كذّاب فساقط.»[99]
فظهر أنّ تضعيف الدارقطني في أدنى مراتب الجرح، ولا يوجب سقوط روايته.
- ليس هنا ما يوجب طرح أحاديث أحمد بن عيسى إلّا ما نسب إلى محمّد بن طاهر المقدسي؛ ونلاحظ عليه بوجهين:
الأوّل: إنّ محمّد بن طاهر ليس من معاصري أحمد بن عيسى الخشّاب، وليس قوله خبراً عن حسّ بل هذا رأيه واجتهاده في الحكم عليه، ولا يلزمنا اجتهاده شيئاً بالنظر إلى أقوال أكابر علماء الجرح والتعديل، مضافاً إلى ما ستقف عليه.
والثاني: لا يمكن الأخذ بقول محمّد بن طاهر وإنْ كان جرحه بكلام متوسّط؛ لأنّ له أوهاماً في كتبه كما أورده الذهبي في كتابه ميزان الإعتدال، وقال:
«ليس بالقوي، فإنّه له أوهام كثيرة في تواليفه.»[100]
فوهم محمّد بن طاهر في ترجمة أحمد بن عيسى، وزعم أنّه كذّاب ووضع بعض الأحاديث.
- إنّ أعلام القوم كابن عدي لم يذكروا هذا الحديث في ترجمته من جملة الأحاديث المكذوبة أو الضّعيفة … بل الذي روي هناك وضعّف من جهته يدلّ على ميله إلى بني أميّة؛ وهذا يقوي روايته في فضل أميرالمؤمنين عليه السّلام.
هذا؛ وهناك أمور أخر بملاحظتها تقف على أنّ هذا الحديث لم يعتلّ من جهة أحمد بن عيسى أبداً، بل يعدّ من الأحاديث الصّحيحة؛ فأقول:
- حديث أحمد بن عيسى مخرّج في الصّحيح
أخرج ابن خزيمة النيسابوري (م. 311) حديث أحمد بن عيسى في موضعين من صحيحه[101]، بل هو من شيوخه، ولا يخفى أنّ تلميذه هذا، أعلم بشيخه وبقيمة أحاديثه.
أخرج ابن خزيمة في باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء والنّظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها:
«ثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبّار بن مالك اللخمي التنّيسي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا مُهَير بن محمّد المكّي، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله أنّ عائشة، كانت تقول:
عجباً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قِبَل السّقف، يدع ذلك إجلالاً لله وإعظاماً؛ دخل رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتّى خرج منها.»[102]
والجدير بالذكر أنّه اكتفى بحديثه في هذا الباب وما تابع عليه، وما أردفه بشيء نحو: «إن صحّ» وما شابهه.
ولجلال الدين السيوطي (م. 911) كلمةٌ مهمّة في تدريب الراوي حول صحيح ابن خزيمة، قال:
«صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبّان لشدّة تحرّيه، حتّى أنّه يتوقّف في التّصحيح لأدنى كلامٍ في الإسناد، فيقول: إنْ صحّ الخبر، أو إنْ ثبت كذا ونحو ذلك.»[103]
وعليه فإنّ حديثه هذا صحيحٌ معتبرٌ قطعاً، وليس أدنى كلامٍ في إسناده.
ولو أغمضنا عنه، فنصحّح الحديث أيضاً بالنظر إلى ما يلي:
- استشهد الحاكم بحديث أحمد بن عيسى
إنّ الحاكم النيسابوري جعل هذا الحديث شاهداً على سابقه[104]، فيكون حديثه عند الحاكم على مرتبة يشهد على ما رواه أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبّار، عن يونس بن بكير، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عبّاس.
- هذا الحديث روي بطريق آخر
قد عرفت أنّ الخطيب البغدادي (م. 463) قد روى هذا الحديث من طريق آخر:
عن شيخه الطّاهري، عن لؤلؤ بن عبد الله القيصري، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد النصيبي الصوفي، عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن شدّاد، عن محمّد بن سنان الحنظلي، عن إسحاق بن بشر القرشي، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه.
فمدار الحديث على بهز بن حكيم. ومن نظر في طبقات الطّريقين يعلم أنّ تواطؤهما على الكذب من المحال. مع أنّ إسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه إسناد صحيح كما ستعرف عن يحيى بن معين[105]، وله نسخة حسنة.[106]
فصار الحديث ممّا لم ينفرد أحمد بن عيسى به؛ فخرج ممّا سبق في تضعيفه.
هذا؛ والجدير بالذكر أنّ ابن أبي الحديد (م. 656) روى عن حذيفة بن اليمان -موقوفاً- ما يشهد على هذا الحديث، قال:
«روى قيس بن الربيع، عن أبي هارون العبدي، عن ربيعة بن مالك السعدي، قال:
أتيت حذيفة بن اليمان فقلت: يا أبا عبد الله إنّ النّاس يتحدّثون عن علي بن أبي طالب [عليه السّلام] ومناقبه، فيقول لهم أهل البصيرة: إنّكم لتفرطون في تقريظ هذا الرجل، فهل أنت محدّثي بحديث عنه أذكره للنّاس؟
فقال: يا ربيعة وما الذي تسألني عن علي [عليه السلام] وما الذي أحدّثك عنه، والذي نفس حذيفة بيده لو وضع جميع أعمال أمّة محمّد صلّى الله عليه [وآله] وسلّم في كفّة الميزان منذ بعث الله تعالى محمّداً إلى يوم النّاس هذا، ووضع عمل واحد من أعمال عليّ في الكفّة الأخرى لرجح على أعمالهم كلّها.
فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل، إنّي لأظنّه إسرافاً يا أبا عبد الله.
فقال حذيفة: يا لكع وكيف لا يحمل؟ وأين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه فملكهم الهَلَع والجزع، ودعا إلى المبارزة فأحجموا عنه حتّى برز إليه علي [عليه السّلام] فقتله؟
والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أعمال أمّة محمّد صلّى الله عليه [وآله] وسلّم إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة.»[107]
وهذا الحديث رواه محمّد بن سليمان الكوفي (كان حيّاً 300) في كتابه مناقب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام، بإسناده متّصلاً عن حذيفة بن اليمان، قال:
«حدّثنا خضر بن أبان، قال: حدّثنا يحي بن عبد الحميد الحماني، عن قيس بن الرّبيع، عن أبي هارون العبدي، عن ربيعة السعدي قال:
أتيت حذيفة بن اليمان فقلت: يا أبا عبد الله إنّا نتحدّث في عليّ [عليه السّلام] وفي مناقبه، فيقول لنا أهل البصرة: إنّكم لتفرطون في عليّ وفي مناقبه. فهل أنت تحدّثني بحديث في علي؟
فقال حذيفة:
يا ربيعة إنّك لتسألني عن رجل والذي نفسي بيده لو وضع عمل جميع أصحاب محمّد صلّى الله عليه [وآله] وسلّم في كفّة الميزان من يوم بعث الله محمّداً إلى يوم النّاس هذا، ووضع عمل علي [عليه السّلام] يوماً واحداً في الكفّة، لرجح عمله على جميع أعمالهم.
فقال ربيعة: هذا الذي لا يقام له ولا يقعد.
فقال حذيفة: وكيف لا يحتمل هذا يا ملكعان! أين كان أبو بكر وعمر وحذيفة ثكلتك أمّك وجميع أصحاب محمّد يوم عمرو بن عبد ودّ ينادي للمبارزة؟ فأحجم النّاس كلّهم ما خلا عليّاً فقتله الله على يديه، والذي نفسي بيده لعمله ذلك اليوم أعظم عند الله من جميع أعمال أمّة محمّد إلى يوم القيامة.»[108]
ورواه أصحابنا الإماميّة أيضاً كالشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف[109]؛ وهذا يشهد على أنّ أفضليّة مبارزة أميرالمؤمنين عليه السّلام في يوم الخندق كان ممّا يعرفها ويرويها غير واحد من أكابر الأصحاب.
وهذا تمام الكلام في ترجمة أحمد بن عيسى الخشّاب وإثبات صحّة الحديث في هذه الطبقة؛ وإليك الكلام في تراجم باقي الرواة.
ترجمة عمرو بن أبي سلمة
هو: أبو حفص عمرو بن أبي سلمة التنّيسي من موالي بني هاشم.
حدّث عن الأوزاعي، وأبي معيد حفص بن غيلان، وعبد الله ابن العلاء بن زبر، ومالك بن أنس، وإدريس بن يزيد الأودي، وعدّة.[110] وأمّا سماعه عن سفيان الثوري، فثابت بنفس لفظ الأداء.
حدّث عنه ولده سعيد، وأبو عبد الله الشافعي، ودحيم، وعبد الله بن محمّد المسندي، وأحمد بن صالح، والذهلي، وابن وارة، ومحمّد ابن عبد الله بن البرقي، وأخوه أحمد، وعبد الله بن محمّد بن أبي مريم، وأحمد بن مسعود المقدسي، وأحمد بن عبد الواحد بن عبود، وخلق.[111] وقد عرفت سابقاً سماع أحمد بن عيسى الخشّاب منه.
مات عمرو بن أبي سلمة سنة أربع عشرة ومائتين على ما قال الفسوي (م. 277).[112]
روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والتّرمذي، والنّسائي، وابن ماجه.[113]
وإجماع أصحاب الصّحاح في تخريج حديثه في الصّحيح، يكشف عن مكانته عند أئمّة القوم وصحّة حديثه.
مضافاً إلى أنّ أبا سعيد ابن يونس الصدفي (م. 347) وثّقه في تاريخه[114]؛ وكذا ابن حبّان (م. 354) في الثقات.[115]
ووصفه شمس الدين الذهبي (م. 748) في سير أعلام النبلاء بالإمام، الحافظ، الصّدوق.[116]
ترجمة سفيان الثّوري
هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثّوري الكوفي.
ولد سنة سبع وتسعين[117]، وقال ابن سعد (م. 230): «وأجمعوا لنا على أنّه توفّي بالبصرة وهو مستخف في شعبان سنة إحدى وستّين ومائة.»[118]
حدّث عن كثير من شيوخ الرواة وأعلام الحديث، منهم بهز بن حكيم.[119]
روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والتّرمذي، والنّسائي، وابن ماجه.[120]
وأمّا سفيان الثوري فهو من أئمّة القوم في هذا الفنّ حتّى قال شعبة، وسفيان بن عيينة، وأبو عاصم النبيل، ويحيى بن معين، وغير واحد منهم: سفيان أمير المؤمنين في الحديث![121] وعليه نكتفي ببعض ما قيل في ترجمته:
قال ابن سعد (م. 230):
«كان ثقة مأموناً ثبتاً كثير الحديث حجة.»[122]
قال علي ابن المديني (م. 234) شيخ البخاري[123]:
«نظرت فإذا الإسناد يدور على ستّة: الزهري وعمرو بن دينار وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأبو إسحاق والأعمش؛ ثمّ صار علم هؤلاء الستّة من أهل الكوفة إلى سفيان الثوري.»[124]
وقال أحمد بن عبد الله العجلي (م. 261):
«ثقة، كوفي، رجل صالح، زاهد، عابد، ثبت في الحديث.»[125]
ترجمة بهز بن حكيم
هو: أبو عبد الملك بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري.
روى عن أبيه عن جدّه، وعن زرارة بن أوفى.[126]
وروى عنه سفيان الثوري، وسليمان التيمي ـ وهو من أقرانه ـ وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، ويحيى بن سعيد القطان وآخرون.[127]
استشهد به البخاري في الصّحيح، وروى له في الأدب وغيره، وروى له الباقون سوى مسلم.[128]
سئل يحيى بن معين (م. 233) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه فقال:
«إسناد صحيح.»[129]
قال عثمان الدارمي (م. 280):
«سألته [أي يحيى بن معين] عن بهز بن حكيم، كيف حديثه؟
فقال: ثقة.»[130]
وهكذا في رواية الدوري عنه.[131]
وقال علي ابن المديني (م. 234):
«بهز بن حكيم ثقة.»[132]
وأورده ابن شاهين (م. 385) في تاريخ أسماء الثقات، ووثّقه.[133]
وقال الدار قطني (م. 385):
«لا بأس به.»[134]
وقال النووي (م. 676) في التقريب والتيسير في رواية الأبناء عن آبائهم:
«بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جدّه، له هكذا نسخة حسنة.»[135]
وقال الذهبي (م. 748):
«وثّقه ابن معين، وعلي، وأبو داود، والنّسائي. وقال أبو داود أيضاً: هو عندي حجّة.»[136]
وهذا يكفي لتصحيح الحديث في هذه الطبقة، مع أنّ في ترجمته فوائد لا يسع المقام لذكرها.
ترجمة حكيم بن معاوية
هو: حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري. والد بهز بن حكيم، وسعيد بن حكيم، ومهران بن حكيم.
روى عن أبيه، وسمع منه ابنه بهز والجريري[137]، وغيرهما.
استشهد به البخاري في الصّحيح، وروى له في الأدب. وروى له الباقون سوى مسلم.[138]
وخرّج ابن حبّان حديثه في صحيحه، وكذلك الحاكم النيسابوري.[139]
ذكر الحسن بن محمّد الصغاني (م. 650): أنّ صحبته مختلف فيها.[140]
قال العجلي (م. 261):
«حكيم بن معاوية أبو بهز: تابعيٌ، ثقة.»[141]
وقال النسائي (م. 303):
«ليس به بأس.»[142]
وأورده ابن حبّان (م. 354) في الثقات.[143] وقال في مشاهير علماء الأمصار: «من صالحي أهل البصرة.»[144]
ترجمة معاوية بن حيدة
هو: معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب.
وهو صحابيّ، قال ابن سعد (م. 230):
«وفد على النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فأسلم وصحبه، وسأله عن أشياء وروى عنه أحاديث.»[145]
وكذا أورده ابن قانع (م. 351) في معجم الصّحابة.[146]
وأورده ابن عبد البرّ (م. 463) في الإستيعاب في معرفة الأصحاب، وقال:
«معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب القشيري، معدود في أهل البصرة، غزا خراسان، ومات بها. ومن ولده بهز بن حكيم الذي كان بالبصرة.»[147]
الحكم على هذا الإسناد
قد ظهر ممّا قدّمناه أنّ إسناد حديث أفضلّية مبارزة أمير المؤمنين عليه السّلام يوم الخندق من أعمال الأمّة إلى يوم القيامة، صحيحٌ معتبرٌ بالإستناد إلى أقوال أئمّة الجرح والتعديل عند القوم.
( 4 )
تصحيح علماء الحديث
قد عرفت -بالتفصيل- أنّ هذا الحديث -بإسناد الحاكم النيسابوري- صحيحٌ معتبر لا شك فيها. هذا وإنْ كان كافياً للاحتجاج به، إلّا أنّ لتصحيح علماء القوم فوائد يقوى الحديث بها.
استشهاد الحاكم بهذا الحديث
قد تقدّم أنّ الحاكم النيسابوري استشهد بهذا الحديث على ما رواه أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبّار، عن يونس ابن بكير، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عبّاس.[148]
وهذا يكشف عن مدى اعتبار الحديث عند الحاكم.
تصحيح شمس الدين الذهبي
إنّ شمس الدين الذهبي (م. 748) صحّح هذا الحديث بإسناد الحاكم في تلخيصه للمستدرك، على ما نقل عنه جلال الدين السيوطي (م. 911) في كتابه جامع الأحاديث.[149]
ولكن قد حرّف كلام الذهبي في تلخيصه، فإنّ كتابه اليوم خال عن هذا التصحيح بل جاء فيه: «قبّح الله رافضيّاً افتراه.»[150]
وهكذا فيما نقل عنه المتّقي الهندي في كنز العمّال ، وهو إمّا نقل عن النسخة المختلقة وإمّا ناله التحريف بعد.
وأمّا من حرّف كلام الذهبي فليس إلّا جاهلاً، لأنّ هذا الإسناد لا يشتمل على رافضيّ، فكيف يقول: قبّح الله رافضيّاً افتراه؟! وهذا شاهد على أنّه تحريف وتدليس من الجهّال.
نعم؛ تحريف الروايات والكلمات، ووضع الأحاديث وتكذيبها، وجرح الرّواة، وتزوير الكتب المطبوعة بالتحريف والحذف و… صار ديدن القوم بالنسبة إلى فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم آلاف التحيّة والثناء.
فعليك بمراجعة نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار حتّى تعرف بعض هذه المحاولات الشنيعة.
( 5 )
النظر في كلام من ضعّف هذا الحديث
ما وجدنا في كتب متقدّمي العامّة أحداً ضعّف هذا الحديث … ولو كان عندهم ضعيفاً عندهم لصرّحوا بذلك.
وأمّا المتأخّرون، فأورده شيخ النّواصب ابن تيميّة في كتابه وزعمه موضوعاً، وما أعلّه بشيء إلّا قول نفسه بأنّه كذبٌ! ولا بأس فإنّه من نظر في كتابه لوجده جاهلاً بعلم الحديث وقواعده الواضحة فضلاً عن دقائق هذا الفنّ.
قال:
«والحديث الذي ذكره عن النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أنّه قال:
قتل علي لعمرو بن عبد ودّ أفضل من عبادة الثقلين.
من الأحاديث الموضوعة، ولهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين في شيء من الكتب التي يعتمد عليها، بل ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف.
وهو كذب لا يجوز نسبته إلى النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم، فإنّه لا يجوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجنّ والإنس، فإنّ ذلك يدخل فيه عبادة الأنبياء، وقد قتل من الكفّار من كان قتله أعظم من قتل عمرو بن عبد ودّ.
وعمرو هذا لم يكن فيه من معاداة النبي صلّى الله عليه وسلّم ومضارّته له وللمؤمنين، مثل ما كان في صناديد قريش الذين قتلوا ببدر، مثل أبي جهل، وعقبة ابن أبي معيط، وشيبة بن ربيعة، والنضر بن الحارث، وأمثالهم الذين نزل فيهم القرآن.
وعمرو هذا لم ينزل فيه شيء من القرآن ولا عرف له شيء ينفرد به في معاداة النبي صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنين.
وعمرو بن عبد ودّ هذا لم يعرف له ذكر في غزاة بدر ولا أحد، ولا غير ذلك من مغازي قريش التي غزوا فيها النبي – صلّى الله عليه وسلّم ـ ولا في شيء من السّرايا، ولم يشتهر ذكره إلّا في قصّة الخندق، مع أنّ قصّته ليست مذكورة في الصّحاح ونحوها، كما نقلوا في الصّحاح مبارزة الثلاثة يوم بدر إلى الثلاثة: مبارزة حمزة وعبيدة، وعلي مع عتبة، وشيبة والوليد.
وكتب التفسير والحديث مملوءة بذكر المشركين الذين كانوا يؤذون النبيّ صلّى الله عليه وسلم مثل أبي جهل، وعقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وغيرهم، وبذكر رؤساء الكفّار، مثل الوليد بن المغيرة وغيره، ولم يذكر أحد عمرو بن عبد ودّ، لا في هؤلاء ولا في هؤلاء، ولا كان من مقدّمي القتال، فكيف يكون قتل مثل هذا أفضل من عبادة الثقلين؟
ومن المنقول بالتواتر أنّ الجيش لم ينهزم بقتله، بل بقوا بعده محاصرين مجدّين كما كانوا قبل قتله.»[151]
أقول:
هناك نقاط مهمّة:
- إنّ هذا الحديث صحيح بالإستناد إلى أقوال أعلام العامّة كما عرفت بالتفصيل، ولهذا لم يجد هذا الناصبي سبيلاً إلى تعليله وتضعيفه، فتشبّث بادعاء تكذيب الحديث فقط.
ولا يخفى أنّ هذا ليس منهجاً مقبولاً في أيّ مجتمع علميّ؛ ولو فتح هذا الباب لأصبحت الأحاديث والأخبار لعبةً بأيدي الجهّال وأصحاب الأهواء.
- إنّه أفضى بجهله وعداوته لأميرالمؤمنين عليه السّلام إلى فضيحة أخرى حيث قال: «ولهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين في شيء من الكتب التي يعتمد عليها، بل ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف.»
هذا كذب صراح، كيف لم يروه أحد من علماء المسلمين حتّى بإسناد ضعيف مع ما تقدّم من اتّفاق الفريقين على روايته؟! ولعلّ الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي وعبيد الله الحسكاني وغيرهم لم يكونوا من علماء المسلمين عند ابن تيميّة!
- وأمّا قوله: وهو كذب لا يجوز نسبته إلى النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم، فإنّه لا يجوز … إلى آخره.
فهو ردّ للنص بالقياس؛ وقد ثبت في محلّه أنّ ردّ النصّ بالقياس مردود، بل قوله: «فإنّه لا يجوز»، ردّ لرسول الله صلّى الله عليه وآله ومخالفة لحكمه، حيث ثبت بسند صحيح عن رسول الله صلّى الله عليه وآله تفضيل مبارزة أميرالمؤمنين عليه السّلام.
وتقدّم أنّ عليّ بن إبراهيم الحلبي ردّ عليه من هذا الجهة، فليراجع.[152]
- وبقوله في عمرو بن عبد ودّ، أبان جهله أيضاً … فإنّ عمرو ابن عبد ودّ من فرسان وشجعان قريش ومن مشاهير الأبطال، يعدّ بألف رجل.
وهو الذي كان على ميسرة المشركين يوم بدر[153]، وجُرح في هذه الغزوة، وبسببها لم يشهد أحداً؛ وقد جهل ابن تيميّة هذه الأمور أيضاً.
وقد تقدّم في ترجمة عمرو ذكر شجاعته وخبره في غزوة بدر والخندق، فليراجع.[154]
وتقدّم أنّ عليّ بن إبراهيم الحلبي ردّ علىه من هذه الجهة أيضاً.[155]
هذا تمام الكلام مع ابن تيميّة.
وقد تبعه ابن حجر العسقلاني في تضعيف الحديث وقال بعد نقله: «قلت: هذا خبر موضوع.»[156]
أقول:
ليس عنده شيء أكثر من هذا، وقد عرفت صحّة إسناد الحديث، وحينئذٍ لا يصغى إلى ما لا دليل عليه. ولا غرو في ذلك؛ فإنّه عرف دلالة الحديث على إمامة مولانا أميرالمؤمنين عليه السّلام؛ فكذّبه.
وأمّا تعليل بعض متعصّبي المعاصرين[157] بأحمد بن عيسى الخشّاب، فقد عرفت ما فيه بالتفصيل.[158]
( 6 )
من أرسل هذا الحديث إرسال المسلّمات
إنّ بعض أعلام العامّة ذكروا هذا الحديث في كتبهم المختلفة، وأرسلوه إرسال المسلّمات؛ وهذا يشهد على ما تقدّم من صحّته عند علماء القوم.
فإليك بعض من ذكره كذلك:
1 . عضد الدين الإيجي (م. 576)
قال الإيجي في الأدلّة الدالّة على أفضلية أميرالمؤمنين عليه السّلام عند قائليه في كتابه المواقف:
«الرابع: الشجاعة، تواتر مكافحته للحروب ولقاء الأبطال وقتل أكابر الجاهليّة حتّى قال عليه السّلام يوم الأحزاب:
لضربة علي خيرٌ من عبادة الثّقلين.
وتواتر وقائعه في خبير وغيره.»[159]
2 . فخر الدين الرازي (م. 606)
أورد فخر الدين الرازي هذا الحديث في التفسير الكبير، واستشهد به[160] وأرسله إرسال المسلّمات؛ قال:
«المسألة الثانية: هذه الآية [الآية 3 من سورة القدر] فيها بشارة عظيمةٌ وفيها تهديد عظيم.
أمّا البشارة، فهي أنّه تعالى ذكر أنّ هذه الليلة خيرٌ ولم يبيّن قدر الخيريّة، وهذا كقوله عليه السّلام:
لمبارزة علي عليه السّلام مع عمرو بن عبد ودّ أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة.»[161]
وأورده أيضاً في الأربعين في أصول الدين، في الأدلّة الدالّة على أفضلية أميرالمؤمنين عليه السّلام عند قائليه:
«منها [الفضائل النفسانيّة العمليّة] الشجاعة، وقد كان في الصّحابة جماعة شجعان كأبي دجانة، وخالد بن الوليد وكانت شجاعته أكثر نفعاً من شجاعة الكلّ.
ألا ترى أنّ النبيّ عليه السّلام قال يوم الأحزاب:
لضربة علي خير من عبادة الثقلين.
وقال علي بن أبى طالب [عليه السلام]:
والله ما قلعت باب خيبر بقوّة جسمانيّة، لكن بقوّة رحمانيّة.»[162]
3 . ابن أبي الحديد (م. 656)
قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة:
«فأمّا الخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد ودّ، فإنّها أجلّ من أن يقال جليلة وأعظم من أن يقال عظيمة؛ وما هي إلّا كما قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله سائل:
أيّما أعظم منزلة عند الله عليٌ أم أبو بكر؟
فقال: يا ابن أخي والله لمبارزة علي عمراً يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلّها وتربي عليها، فضلاً عن أبي بكر وحده.
وقد روي عن حذيفة بن اليمان ما يناسب هذا بل ما هو أبلغ منه.»[163]
ثمّ ذكر ما روي عن حذيفة، وقد أوردناه سابقاً؛ فليراجع.[164]
4 . سعد الدين التفتازاني (م. 793)
قال التفتازاني في جملة الأدلّة الدالّة على أفضلية أميرالمؤمنين عليه السّلام عند قائليه من الشيعة والمعتزلة:
«أشهد على ما يشهد به غزواته، حتّى قال النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم:
لضربة علي خير من عبادة الثقلين.»[165]
وإنّه لم يستشكل على إسناد الحديث في مقام الجواب.
5 . نظام الدين النيسابوري (م. 850)
قال النيسابوري في تفسير سورة القدر، ما يشابه قول الفخر الرازي، وأرسل هذا الحديث إرسال المسلّمات:
«السادسة: في الآية بشارةٌ عظيمة للمطيعين وتهديد بليغ للعاصين.
أمّا الأوّل فلأنّه تعالى ذكر أنّ هذه الليلة خيرٌ من ألف شهر ولم يبيّن قدر الخيريّة، وهذا كقوله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم:
مبارزة عليّ مع عمرو بن عبد ودّ أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة.»[166]
6 . أبو سعيد الخادمي الحنفي (م. 1156)
أورده أبو سعيد الخادمي في كتابه بريقة محموديّة في شرح طريقة محمّديّة وشريعة نبويّة في سيرة أحمديّة، وأرسله إرسال المسلّمات، قال:
«إنّ جميع الفرق ينسبون إليه في الأصول والفروع، وكذا المتصوّفة في تصفية الباطن، وابن عبّاس رئيس المفسّرين تلميذه وعلمه وفصاحته وفقهه في الدرجة القصوى.
وأنّه أزهد النّاس في الدنيا مع اتّساع أبواب الدنيا ولا يلتفت إلى الدنيا، وتخشن في المآكل والملابس حتّى قال للدنيا: «طلّقتك ثلاثاً».
وأنّه أكرم النّاس وأسخاهم حتّى يؤثر المحاويج على نفسه وأهله، حتّى تصدّق في الصّلاة بخاتمه وتصدّق في ليالي صيامه المنذور بما كان فطوره ونزل فيه: ﴿ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكيناً ويَتيماً وأَسيراً﴾.[167]
وأنّه أشجع النّاس في الحروب حتّى قال صلّى الله تعالى عليه [وآله] وسلّم يوم الأحزاب:
لضربة علي خير من عبادة الثقلين.»[168]
( 7 )
دلالة الحديث على إمامة أميرالمؤمنين عليه السّلام
ثبت في المباحث العامّة للإمامة أنّ الأفضل بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله يكون هو الإمام بحكم الشرع والعقل والعقلاء.
وقد قال الله عزّو جلّ: ﴿فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدينَ عَلَى الْقاعِدينَ أَجْراً عَظيماً﴾.[169]
وأمّا دلالة هذا الحديث على أفضليّة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، فلا تحتاج إلى بيان واستدلال؛ كيف وأنّ منطوق هذا الحديث الصّحيح الثابت عند الفريقين أفضليّة هذا العمل الوحيد منه عليه السّلام، مِن أعمال أمّة رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى يوم القيامة. فكيف بجميع أعمال أميرالمؤمنين عليه السّلام؟!
ومن نظر في قضيّة يوم الخندق وقول رسول الله صلّى الله عليه وآله في مبارزة أميرالمؤمنين عليه السّلام، يعلم أنّه أفضل بالشجاعة وبالنسبة إلى الدفاع عن الإسلام والمسلمين أيضاً مضافاً إلى أفضليّته بمعنى أقربيّته عند الله عزّ وجلّ.
ولا يخفى أنّ هذا الحديث خصيصةٌ من خصائصه الكثيرة الثابتة بأسانيد صحيحة، وصاحبها أفضل من غيره؛ وغيره في هذا الحديث جميع الأمّة إلى يوم القيامة.
وقد علم حذيفة بن اليمان دلالته على أفضليّته عليه السّلام، وهكذا أبو الهذيل وآخرون؛ ولولا دلالته على أفضليّة أمير المؤمنين عليه السّلام لما أنكره ابن تيميّة، فإنّه يعترف بعدم جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل.
وإذا ثبت أنّ أميرالمؤمنين هو الأفضل، فيكون إماماً وخليفةً بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله بلا فصلٍ.
وهذا تمام الكلام حول هذا الحديث الشّريف؛ وتمّت هذا المقال لتسع ليال بقين من صفر سنة سبع وثلاثين وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة علی هاجرها وآله ألف تحيّة وسلام.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
پینوشتها:
[1]. ابن مندة العبدي، المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة، حقّقه عامر حسن صبري التميمي، الأجزاء 3، البحرين، وزارة العدل والشئون الإسلامية، ج 1، ص 218.
[2]. محمّد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، حقّقه محمد زهير بن ناصر الناصر، الأجزاء 9، الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، 1422 هـ.، ج 5، ص 107.
[3]. أبو زرعة الدمشقي، تاريخ أبي زرعة الدمشقي، رواية أبي الميمون بن راشد، تحقيق شكر الله نعمة الله القوجاني، الأجزاء 1، دمشق، مجمعÃ Ä اللغة العربية، ص 165.
[4]. محمّد بن حبيب، المحبّر، حقّقته إيلزة ليختن شتيتر، الأجزاء 1، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ص 113.
[5]. ابن قتيبة الدينوري، المعارف، حقّقه ثروت عكاشة، الأجزاء 1، الطبعة الثانية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992م، ص 161.
[6]. جمال الدين ابن هشام، السيرة النبويّة، حقّقه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، الأجزاء 2، الطبعة الثانية، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1375 هـ/1955م، ج 2، ص 214.
[7]. الواقدي، المغازي، حقّقه مارسدن جونس، الأجزاء 3، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الأعلمي، 1409 هـ./1989م.، ج 2، ص 440 ـ 441.
[8]. محمّد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، الأجزاء 11، الطبعة الثانية، بيروت، دار التراث، 1387 هـ، ج 2، ص 564.
[9]. راجع: السيرة النبويّة، ج 2، ص 214. تاريخ الطبري، ج 2، ص 565. ابن المنذر النيسابوري، كتاب تفسير القرآن، حقّقه سعد بن محمد السعد، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، المدينة النبوية، دار المآثر، 1423هـ/2002م، ج 2، ص 744. ابن حبان، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، حقّقه السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، الأجزاء 2، الطبعة الثالثة، بيروت، الكتب الثقافية، 1417هـ، ج 1، ص 254.
[10]. الواقدي، المغازي، ج 2، ص 441 ـ 442.
[11]. ابن بابويه، الخصال، حقّقه علي اكبر الغفاري، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1362هـ. ش، ج 2، ص 368 ـ 369.
[12]. سورة الأحزاب (33): 10 ـ 13.
[13]. يحيى بن سلام، تفسير يحيى بن سلام، حقّقته هند شلبي، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1425هـ/2004م، ج 2، ص 704.
[14]. مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، حقّقه عبد الله محمود شحاته، الأجزاء 5، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث، 1423 هـ، ج 3، ص 476.
[15]. سورة الأحزاب (33): 22.
[16]. راجع: تاريخ الطبري، ج 2، ص 556. المسعودي، التنبيه والإشراف، صحّحه عبد الله إسماعيل الصاوي، الأجزاء 1، القاهرة، دار الصاوي، ص 216. أبو الفرج ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، حقّقه محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، الأجزاء 19، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1412 هـ/1992م، ج 3، ص 228.
[17].الواقدي، المغازي، ج 2، ص 445.
[18]. محمّد بن سعد، الطبقات الكبرى، حقّقه محمّد عبد القادر عطا، الأجزاء 8، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1410 هـ/1990م، ج 4، ص 62.
[19]. الواقدي، المغازي، ج 2، ص 460.
[20]. المصدر.
[21]. المصدر، ج 2، ص 470.
[22]. المصدر.
[23]. المصدر، ج 2، ص 470.
[24]. محمّد بن إسحاق ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، حقّقه د. محمد مصطفى الأعظمي، الأجزاء 4، بيروت، المكتب الإسلامي، ج 1، صÃ Ä 493.
[25]. هكذا في النسخة، والصّحيح: فليس للعرب درعٌ خيرٌ منها.
[26]. محمّد بن عبد الله الحاکم النيسابوري، المستدرك علی الصحيحين، حقّقه مصطفى عبد القادر عطا، الأجزاء 4، الطبعة الأولی، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411 هـ/1990م، ج 3، ص 35.
[27]. قيل للترس: مجنّ بكسر الميم، لأنّ صاحبه يتستر به. راجع: الفيّومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الأجزاء 2، بيروت، المكتبةÃ Ä العلمية، ج 1، ص 111.
[28]. تاريخ الطبري، ج 2، ص 575 ـ 576.
[29]. محمّد بن حبيب البغدادي، المنمق في أخبار قريش، حقّقه خورشيد أحمد فاروق، الأجزاء 1، الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، 1405 هـ/1985م، ص 419 ـ 420.
[30]. الديار بكري، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، الأجزاء 2، بيروت، دار صادر، ج 1، ص 486.
[31]. المنمق في أخبار قريش، ص 413 ـ 414.
[32]. راجع: محمّد بن عمر الواقدي، المغازي، حقّقه مارسدن جونس، الأجزاء 3، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الأعلمي، 1409 هـ/1989م، ج 1، ص 58.
[33]. جمال الدين ابن هشام، السيرة النبوية، ج 2، ص 225.
[34]. تاريخ الطبري، ج 2، ص 574.
[35]. المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 34.
[36]. الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، حقّقه أبو محمّد بن عاشور، الأجزاء 10، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1422هـ/2002م، ج 8، ص 15.
[37]. ابن عبد البر، الدرر في اختصار المغازي والسير، حقّقه شوقي ضيف، الأجزاء 1، الطبعة الثانية، القاهرة، دار المعارف، 1403 هـ، ص 174.
[38]. الواقدي، المغازي، ج 1، ص 146. والطبقات الكبرى، ج 3، ص 367.
[39] . الواقدي، المغازي، ج 1، ص 145. والطبقات الكبرى، ج 3، ص 110.
[40]. ابن أبي الدنيا، مكارم الأخلاق، حقّقه مجدي السيد إبراهيم، الأجزاء 1، القاهرة، مكتبة القرآن، ص 68.
[41]. المصدر.
[42]. راجع: الصفحة: 24، والمصدر السابق، والمستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 34.
[43]. مكارم الأخلاق، ص 68.
[44]. راجع: جمال الدين ابن هشام، السيرة النبوية، ج 2، ص 225.
[45]. المغازي، ج 2، ص 470 ـ 471.
[46]. المصدر، ج 2، ص 481.
[47]. راجع: ابن هشام، السيرة النبويّة، ج 2، ص 268 ـ 269.
[48]. المصدر، ج 2، ص 268.
[49]. سورة الأحزاب (33): الآية 25.
[50]. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، الأجزاء 4، الطبعة الأولى، قم، العلّامة، 1379 هـ، ج 3، ص 134.
[51] . المصدر، ص 135.
[52]. أنظر الصفحة: 36.
[53]. ابن بابويه، محمّد بن علي، الخصال، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1362ش، ج 2، ص 572 ـ 579.
[54]. محمّد بن إدريس الشافعي، الأم، الأجزاء 8، بيروت، دار المعرفة، 1410 هـ/1990م، ج 4، ص 257.
[55]. السيرة النبويّة، ج 2، ص 224 ـ 226.
[56]. الطبقات الكبرى، ج 2، ص 52.
[57]. سورة الأحزاب (33): الآية 25.
[58]. ابن عساكر الدمشقي، تاريخ مدينة دمشق، حقّقه عمرو بن غرامة العمروي، الأجزاء 80، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415 هـ/1995م، ج 42، ص 360.
[59]. المستدرك علی الصحيحين، ج 3، ص 34، ح 4327.
[60]. هو علي بن عبد العزيز الطاهري.
[61]. أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد وذیوله، حقّقه مصطفی عبد القادر عطا، الأجزاء 24، الطبعة الأولى، بيروت، دار الکتب العلمية، 1417هـ، ج 13، ص 19.
[62]. وصفه شمس الدين الذهبي بـ «الإمام، المحدّث، البارع، القاضي». راجع: شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، حقّقه مجموعة من المحقّقين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الأجزاء 25، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، 1405 هـ/1985م، ج 18، ص 268.
[63]. عبيد الله بن عبد الله الحسكاني، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، تهران، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، 1411 هـ، ج 2، ص 14.
[64]. وصفه شمس الدين الذهبي بـ «المحدّث، العالم، الحافظ، المؤرّخ». راجع: سير أعلام النبلاء، ج 19، ص 294.
[65]. شيرويه بن شهردار الهمذاني، الفردوس بمأثور الخطاب، حقّقه السعيد بن بسيوني زغلول، الأجزاء 5، الطبعة الأولی، بيروت، دار الکتب العلمية، 1406 هـ / 1986م، ج 3، ص 455، ح 5406.
[66]. الموفق الخوارزمي، المناقب، حقّقه الشيخ مالك المحمودي، الأجزاء 1، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1414 هـ، ص 106 ـ 107.
[67]. إبراهيم بن محمّد الجويني، فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين، حقّقه الشيخ محمّد باقر المحمودي، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر، 1400 هـ، ج 1، ص 255.
[68]. هو عبد الكريم بن محمّد الرافعي القزويني (م. 623) مؤلّف الشرح الكبير.
[69]. الدَّرَق: ضربٌ من التِّراس يُتّخذ من جلود دوابّ تكون في بلاد الحبش، الواحدة دَرَقَة، والجمع دَرَق وأَدْراق ودِراق. راجع: ابن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، حقّقه رمزي منير بعلبكي، الأجزاء 3، الطبعة الأولى، بيروت، دار العلم للملايين، 1987م، ج 2، ص 635.
[70]. ابن الملقّن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، حقّقه مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بنÃ Ä كمال، الأجزاء 9، الطبعة الأولى، الرياض، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1425هـ/2004م، ج 9، ص 100 ـ 101.
[71]. ابن حجر العسقلاني، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، حقّقه مركز خدمة السنة والسيرة، الأجزاء 19، الطبعة الأولى، 1415 هـ/1994 م، ج 13، ص 331.
[72]. جلال الدين السيوطي، جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير)، الأجزاء 21، بيروت، دار الفكر، 1414هـ/1994م، ج 5، ص 108، ح 17490.
[73]. المتقي الهندي، كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، حقّقه بكري حياني وصفوة السقا، الأجزاء 16، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، 1401 هـ/ 1981م، ج 11، ص 623، ح 33035.
[74]. علي بن إبراهيم الحلبي، السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، الأجزاء 3، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية،Ã Ä 1427 هـ، ج 2، ص 428.
[75]. عبد الحقّ الدهلوي، تجهيز الجيش، مخطوط، ص 407.
[76]. سليمان القندوزي، ينابيع المودة لذوي القربى، حقّقه سيد علي جمال أشرف الحسيني، الأجزاء 3، الطبعة الأولى، دار الأسوة للطباعة والنشر، 1416هـ، ج 1، ص 412.
[77]. المستدرك علی الصحيحين، ج 3، ص 34، ح 4327.
[78]. أبو يعلی الخليلي، الإرشاد في معرفة علماء الحديث، حقّقه د. محمد سعيد عمر إدريس، الأجزاء 3، الطبعة الأولی، الرياض، مکتبة الرشد، 1409 هـ، ج 3، ص 851 ـ 853.
[79]. تاريخ بغداد وذيوله، ج 3، ص 93.
[80]. إبراهيم بن محمّد الصريفيني، المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، حقّقه خالد حيدر، الأجزاء 1، دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع، 1414 هـ، ص 15 ـ 17.
[81]. راجع: تاريخ مدينة دمشق، ج 50، ص 333. ونايف بن صلاح، الرّوض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، الرياض، دار العاصمة للنشر والتوزيع، 1432 هـ/2011م، ج 2، ص 792.
[82]. المصدر.
[83] . تاريخ بغداد وذيوله، ج 13، ص 19.
[84]. المصدر.
[85]. تاريخ مدينة دمشق، ج 71، ص 16.
[86]. سير أعلام النبلاء، ج 15، ص 332.
[87]. المصدر.
[88]. تاريخ مدينة دمشق، ج 71، ص 16.
[89]. شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، حقّقه د. بشار عوّاد معروف، الأجزاء 15، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، 2003 م، ج 7، ص 668.
[90]. تاریخ الإسلام، ج 6، ص 490.
[91]. المصدر.
[92]. مغلطاي بن قليج، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حقّقه أبو عبد الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم، الأجزاء 12، الطبعة الأولی، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1422 هـ/2001م، ج 1، ص 100.
[93]. عبد الرحمن بن أحمد الصدفي، تاريخ ابن يونس المصري، الأجزاء 2، الطبعة الأولی، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421 هـ، ج 1، ص 19.
[94] . محمّد بن حبّان، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، حقّقه محمود إبراهيم زايد، الأجزاء 3، الطبعة الأولی، حلب، دار الوعي، 1396 هـ، ج 1، ص 146.
[95]. ابن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، حقّقه عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الأجزاء 9، الطبعة الأولی، بيروت، الکتب العلمية، 1418هـ/1997م، ج 1، ص 314 ـ 315.
[96]. أبو عبد الرحمن السلمي، سؤالات السلمي للدارقطني، حقّقه فريق من الباحثين، الأجزاء 1، الطبعة الأولى، 1427 هـ، ص 128.
[97]. ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون، حقّقه عبد الله القاضي، الأجزاء 3، الطبعة الأولى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1406 هـ، ج 1، ص 83.
[98]. شمس الدين الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحديث، الأجزاء 1، الطبعة الثانية، حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1412 هـ، ص 82.
[99]. أبو إسحاق الجعبري، رسوم التحديث في علوم الحديث، حقّقه إبراهيم بن شريف الميلي، الأجزاء 1، الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن حزم، 1421 هـ/2000م، ص 104.
[100]. شمس الدين الذهبي، ميزان الإعتدال في نقد الرجال، حقّقه علي محمد البجاوي، الأجزاء 4، الطبعة الأولی، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1382هـ/1963م، ج 3، ص 587.
[101]. راجع: صحيح ابن خزيمة، ج 1، ص 146. وج 4، ص 332.
[102] . صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 332.
[103]. جلال الدين السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، حقّقه أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، الأجزاء 2، دار طيبة، ج 1، ص 115.
[104]. المستدرك علی الصحيحين، ج 3، ص 33، ح 4326.
[105]. أنظر الصفحة: 39.
[106]. أنظر الصفحة: 40.
[107]. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، الأجزاء 20، قم، مكتبة آية الله المرعشي، 1378-1383ش، ج 19، ص 60 ـ 61.
[108]. محمّد بن سليمان، مناقب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب، مخطوطة من مخطوطات مؤسّسة الإمام زيد بن علي بيمن، الورقة 49، أ.
[109]. راجع: الشيخ المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، قم، دار المفيد، 1413هـ، ج 1، ص 103.
[110]. سير أعلام النبلاء، ج 10، ص 213.
[111]. المصدر.
[112]. يعقوب بن سفيان الفسوي، المعرفة والتاريخ، حقّقه أكرم ضياء العمري، الأجزاء 3، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1401هـ/1981م، ج 1، ص 199.
[113]. يوسف بن عبد الرحمن المزّي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حقّقه د. بشار عواد معروف، الأجزاء 35، الطبعة الأولی، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1400هـ/1980م، ج 22، ص 55.
[114]. تاريخ ابن يونس المصري، ج 2، ص 160.
[115]. محمّد بن حبّان، الثقات، تحت مراقبة د. محمّد عبد المعيد خان، الأجزاء 9، الطبعة الأولی، الهند، دائرة المعارف العثمانية، 1393هـ/1973م، ج 8، ص 482.
[116]. سير أعلام النبلاء، ج 10، ص 213.
[117]. الطبقات الكبرى، ج 6، ص 350.
[118]. المصدر.
[119]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج 11، ص 156.
[120]. المصدر، ج 11، ص 169.
[121]. المصدر، ج 11، ص 164.
[122]. الطبقات الكبرى، ج 6، ص 350.
[123]. هو من أعلام هذا الفنّ حتّى قال البخاري: “ما استصغرت نفسي إلّا بين يدي علي”. راجع: شمس الدين الذهبي، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستّة، حقّقه محمّد عوامة أحمد محمّد نمر الخطيب، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، جدة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، 1413هـ/1992م، ج 2، ص 43.
[124]. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، الأجزاء 9، الطبعة الأولی، الهند، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1271هـ/1952م، ج 1، ص 59 ـ 60.
[125]. أحمد بن عبد الله العجلي، تاريخ الثقات، الأجزاء 1، الطبعة الأولی، دار الباز، 1405هـ/1984م، ص 190.
[126]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج 4، ص 260.
[127]. المصدر، ج 4، ص 260 ـ 261.
[128]. المصدر، ج 4، ص 263.
[129]. إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج 4، ص 124.
[130]. يحيی بن معين، تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)، حقّقه د. أحمد محمد نور سيف، الأجزاء 1، دمشق، دار المأمون للتراث، ص 82.
[131]. يحيی بن معين، تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، حقّقه د. أحمد محمد نور سيف، الأجزاء 4، الطبعة الأولی، مکة المکرّمة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1399هـ/1979م، ج 4، ص 124.
[132]. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج 2، ص 430.
[133]. عمر بن أحمد ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات، حقّقه صبحي السامرائي، الأجزاء 1، الطبعة الأولی، الکويت، الدار السلفية، 1404هـ/1984م، ص 49.
[134]. محمّد مهدي المسلمي وآخرون، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله، الأجزاء 2، الطبعة الأولی، بيروت، عالم الكتب للنشر والتوزيع، 2001م، ج 1، ص 158.
[135]. يحيى بن شرف النووي، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، حقّقه محمد عثمان الخشت، الأجزاء 1، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي، 1405 هـ/1985م، ص 98.
[136]. سير أعلام النبلاء، ج 6، ص 253.
[137]. محمّد بن إسماعيل البخاري، التاريخ الكبير، الأجزاء 8، حيدر آباد ـ الدکن، دائرة المعارف العثمانية، ج 3، ص 12.
[138]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج 7، ص 203.
[139]. إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج 4، ص 124.
[140]. المصدر.
[141]. تاريخ الثقات، ص 130.
[142]. تهذيب الكمال في تاريخ أسماء الرجال، ج 7، ص 203.
[143]. الثقات، ج 4، ص 161.
[144]. محمّد بن حبّان، مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، حقّقه مرزوق على ابراهيم، الأجزاء 1، الطبعة الأولى، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1411هـ/1991م، ص 154.
[145]. الطبقات الكبرى، ج 7، ص 35.
[146]. عبد الباقي بن قانع، معجم الصحابة، حقّقه صلاح بن سالم المصراتي، الأجزاء 3، الطبعة الأولی، المدينة المنوّرة، مكتبة الغرباء الأثرية، 1418هـ، ج 3، ص 70.
[147]. ابن عبد البرّ، الإستيعاب في معرفة الأصحاب، حقّقه علي محمد البجاوي، الأجزاء 4، الطبعة الأولى، بيروت، دار الجيل، 1412هـ/1992م، ج 3، ص 1415.
[148]. المستدرك علی الصحيحين، ج 3، ص 33، ح 4326.
[149]. جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير)، ج 5، ص 108، رقم الحديث 17490.
[150]. راجع حاشیة: المستدرك علی الصحيحين، ج 3، ص 34، ح 4327.
[151]. ابن تيميّة الحرّاني، منهاج السنّة النبويّة، حقّقه محمّد رشاد سالم، الأجزاء 9، الطبعة الأولى، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، 1406هـ/1986م، ج 8، ص 108 ـ 110.
[152]. أنظر الصفحة: 26.
[153]. راجع: المغازي، ج 1، ص 58.
[154]. أنظر الصفحة: 14.
[155]. أنظر الصفحة: 26.
[156]. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ج 13، ص 331.
[157]. الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الأجزاء 14، الطبعة الأولى، الرياض، دار المعارف، 1412هـ/1992م، ج 1، ص 576.
[158]. راجع: 31.
[159]. الجرجاني، شرح المواقف، صحّحه بدر الدين النعساني، الأجزاء 4، الطبعة الأولی، قم، الشريف الرضي، ج 8، ص 371.
[160]. إنّ المهمّ في هذا الباب هو إرساله كحديث مسلّم، وأمّا ما يقول في الإستشهاد فلا يهمّنا البحث حوله في هذا المقام.
[161]. فخر الدين الرازي، تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، الأجزاء 32، الطبعة الثالثة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1420هـ، ج 32، ص 231.
[162]. فخر الدين الرازي، الأربعين في أصول الدين، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1986م، ج 2، ص 314.
[163]. شرح نهج البلاغة، ج 19، ص 60.
[164]. أنظر الصفحة: 35.
[165]. سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد، حقّقه د. عبد الرحمن عميرة، الأجزاء 5، الطبعة الأولی، قم، الشريف الرضي، 1409هـ، ج 5، ص 295.
[166]. نظام الدين النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، حقّقه الشيخ زكريا عميرات، الأجزاء 6، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1416هـ، ج 6، ص 538.
[167]. سورة الإنسان (76): الآية: 8.
[168]. أبو سعيد الخادمي، بريقة محموديّة في شرح طريقة محمّديّة وشريعة نبويّة في سيرة أحمديّة، الأجزاء 4، مطبعة الحلبي، 1348هـ، ج 1، ص 211.
[169]. النساء (4): 95.
فهرس المصادر
- ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، الأجزاء 20، قم، مكتبة آية الله المرعشي، 1378-1383ش.
- ابن أبي الدنيا: مكارم الأخلاق، حقّقه مجدي السيد إبراهيم، الأجزاء 1، القاهرة، مكتبة القرآن.
- ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، الأجزاء 9، الطبعة الأولی، الهند، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1271هـ/1952م.
- ابن الجوزي: الضعفاء والمتروكون، حقّقه عبد الله القاضي، الأجزاء 3، الطبعة الأولى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1406 هـ.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، حقّقه محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، الأجزاء 19، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1412 هـ/1992م.
- ابن الملقّن: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، حقّقه مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، الأجزاء 9، الطبعة الأولى، الرياض، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1425هـ/2004م.
- ابن بابويه، محمّد بن علي: الخصال، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1362ش.
- ابن تيميّة الحرّاني: منهاج السنّة النبويّة، حقّقه محمّد رشاد سالم، الأجزاء 9، الطبعة الأولى، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، 1406هـ/1986م.
- ابن حجر العسقلاني: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، حقّقه مركز خدمة السنة والسيرة، الأجزاء 19، الطبعة الأولى، 1415 هـ/1994 م.
- ابن خزيمة، محمّد بن إسحاق: صحيح ابن خزيمة، حقّقه د. محمد مصطفى الأعظمي، الأجزاء 4، بيروت، المكتب الإسلامي.
- ابن دريد الأزدي: جمهرة اللغة، حقّقه رمزي منير بعلبكي، الأجزاء 3، الطبعة الأولى، بيروت، دار العلم للملايين، 1987م.
- ابن شاهين، عمر بن أحمد: تاريخ أسماء الثقات، حقّقه صبحي السامرائي، الأجزاء 1، الطبعة الأولی، الکويت، الدار السلفية، 1404هـ/1984م.
- ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب، الأجزاء 4، الطبعة الأولى، قم، العلّامة، 1379 هـ.
- ابن عبد البرّ: الإستيعاب في معرفة الأصحاب، حقّقه علي محمد البجاوي، الأجزاء 4، الطبعة الأولى، بيروت، دار الجيل، 1412هـ/1992م.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ، الدرر في اختصار المغازي والسير، حقّقه شوقي ضيف، الأجزاء 1، الطبعة الثانية، القاهرة، دار المعارف، 1403 هـ.
- ابن عدي الجرجاني: الكامل في ضعفاء الرجال، حقّقه عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الأجزاء 9، الطبعة الأولی، بيروت، الکتب العلمية، 1418هـ/1997م.
- ابن عساكر الدمشقي: تاريخ مدينة دمشق، حقّقه عمرو بن غرامة العمروي، الأجزاء 80، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415 هـ/1995م.
- ابن هشام، جمال الدين: السيرة النبويّة، حقّقه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، الأجزاء 2، الطبعة الثانية، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1375 هـ/1955م.
- أبو إسحاق الجعبري: رسوم التحديث في علوم الحديث، حقّقه إبراهيم بن شريف الميلي، الأجزاء 1، الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن حزم، 1421 هـ/2000م.
- أبو عبد الرحمن السلمي: سؤالات السلمي للدارقطني، حقّقه فريق من الباحثين، الأجزاء 1، الطبعة الأولى، 1427 هـ.
- الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الأجزاء 14، الطبعة الأولى، الرياض، دار المعارف، 1412هـ/1992م.
- البخاري، محمّد بن إسماعيل: التاريخ الكبير، الأجزاء 8، حيدر آباد ـ الدکن، دائرة المعارف العثمانية.
- التفتازاني، سعد الدين: شرح المقاصد، حقّقه د. عبد الرحمن عميرة، الأجزاء 5، الطبعة الأولی، قم، الشريف الرضي، 1409هـ.
- الثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، حقّقه أبو محمّد بن عاشور، الأجزاء 10، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1422هـ/2002م.
- الجرجاني: شرح المواقف، صحّحه بدر الدين النعساني، الأجزاء 4، الطبعة الأولی، قم، الشريف الرضي.
- الجويني، إبراهيم بن محمّد: فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين، حقّقه الشيخ محمّد باقر المحمودي، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر، 1400 هـ.
- الحاکم النيسابوري، محمّد بن عبد الله: المستدرك علی الصحيحين، حقّقه مصطفى عبد القادر عطا، الأجزاء 4، الطبعة الأولی، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411 هـ/1990م.
- الحسكاني، عبيد الله بن عبد الله: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، تهران، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، 1411 هـ.
- الحلبي، علي بن إبراهيم: السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، الأجزاء 3، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، 1427 هـ.
- الخطيب البغدادي، أحمد بن علي: تاريخ بغداد وذیوله، حقّقه مصطفی عبد القادر عطا، الأجزاء 24، الطبعة الأولى، بيروت، دار الکتب العلمية، 1417هـ.
- الخليلي، أبو يعلی: الإرشاد في معرفة علماء الحديث، حقّقه د. محمد سعيد عمر إدريس، الأجزاء 3، الطبعة الأولی، الرياض، مکتبة الرشد، 1409 هـ.
- الدهلوي، عبد الحقّ: تجهيز الجيش، مخطوط.
- الديار بكري، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، الأجزاء 2، بيروت، دار صادر.
- الذهبي، شمس الدين: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستّة، حقّقه محمّد عوامة أحمد محمّد نمر الخطيب، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، جدة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، 1413هـ/1992م.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ: الموقظة في علم مصطلح الحديث، الأجزاء 1، الطبعة الثانية، حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1412 هـ.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، حقّقه د. بشار عوّاد معروف، الأجزاء 15، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، 2003 م.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ: سير أعلام النبلاء، حقّقه مجموعة من المحقّقين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الأجزاء 25، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، 1405 هـ/1985م.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ: ميزان الإعتدال في نقد الرجال، حقّقه علي محمد البجاوي، الأجزاء 4، الطبعة الأولی، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1382هـ/1963م.
- السيوطي، جلال الدين: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، حقّقه أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، الأجزاء 2، دار طيبة.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ: جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير)، الأجزاء 21، بيروت، دار الفكر، 1414هـ/1994م.
- الشافعي، محمّد بن إدريس: الأم، الأجزاء 8، بيروت، دار المعرفة، 1410 هـ/1990م.
- الشيخ المفيد: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، قم، دار المفيد، 1413هـ.
- شيرويه بن شهردار الهمذاني: الفردوس بمأثور الخطاب، حقّقه السعيد بن بسيوني زغلول، الأجزاء 5، الطبعة الأولی، بيروت، دار الکتب العلمية، 1406هـ/1986م.
- الصدفي، عبد الرحمن بن أحمد: تاريخ ابن يونس المصري، الأجزاء 2، الطبعة الأولی، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421 هـ.
- الصريفيني، إبراهيم بن محمّد: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، حقّقه خالد حيدر، الأجزاء 1، دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع، 1414 هـ.
- عبد الباقي بن قانع: معجم الصحابة، حقّقه صلاح بن سالم المصراتي، الأجزاء 3، الطبعة الأولی، المدينة المنوّرة، مكتبة الغرباء الأثرية، 1418هـ.
- العجلي، أحمد بن عبد الله: تاريخ الثقات، الأجزاء 1، الطبعة الأولی، دار الباز، 1405هـ/1984م.
- فخر الدين الرازي: الأربعين في أصول الدين، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1986م.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ: تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، الأجزاء 32، الطبعة الثالثة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1420هـ.
- الفسوي، يعقوب بن سفيان: المعرفة والتاريخ، حقّقه أكرم ضياء العمري، الأجزاء 3، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1401هـ/1981م.
- القندوزي، سليمان: ينابيع المودة لذوي القربى، حقّقه سيد علي جمال أشرف الحسيني، الأجزاء 3، الطبعة الأولى، دار الأسوة للطباعة والنشر، 1416هـ.
- المتقي الهندي: كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، حقّقه بكري حياني وصفوة السقا، الأجزاء 16، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، 1401 هـ/ 1981م.
- محمّد بن حبّان: الثقات، تحت مراقبة د. محمّد عبد المعيد خان، الأجزاء 9، الطبعة الأولی، الهند، دائرة المعارف العثمانية، 1393هـ/1973م.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ: المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، حقّقه محمود إبراهيم زايد، الأجزاء 3، الطبعة الأولی، حلب، دار الوعي، 1396 هـ.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، حقّقه مرزوق على ابراهيم، الأجزاء 1، الطبعة الأولى، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1411هـ/1991م.
- محمّد بن حبيب: المحبّر، حقّقته إيلزة ليختن شتيتر، الأجزاء 1، بيروت، دار الآفاق الجديدة.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ: المنمق في أخبار قريش، حقّقه خورشيد أحمد فاروق، الأجزاء 1، الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، 1405 هـ/1985م.
- محمّد بن سعد: الطبقات الكبرى، حقّقه محمّد عبد القادر عطا، الأجزاء 8، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1410 هـ/1990م.
- محمّد بن سليمان: مناقب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب، مخطوطة من مخطوطات مؤسّسة الإمام زيد بن علي بيمن.
- محمّد مهدي المسلمي وآخرون: موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله، الأجزاء 2، الطبعة الأولی، بيروت، عالم الكتب للنشر والتوزيع، 2001م.
- المزّي، يوسف بن عبد الرحمن: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حقّقه د. بشار عواد معروف، الأجزاء 35، الطبعة الأولی، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1400هـ/1980م.
- مغلطاي بن قليج: إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حقّقه أبو عبد الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم، الأجزاء 12، الطبعة الأولی، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1422 هـ/2001م.
- الموفّق الخوارزمي: المناقب، حقّقه الشيخ مالك المحمودي، الأجزاء 1، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1414 هـ.
- نايف بن صلاح: الرّوض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم، الأجزاء 2، الطبعة الأولى، الرياض، دار العاصمة للنشر والتوزيع، 1432 هـ/2011م.
- نظام الدين النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، حقّقه الشيخ زكريا عميرات، الأجزاء 6، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1416هـ.
- النووي، يحيى بن شرف: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، حقّقه محمد عثمان الخشت، الأجزاء 1، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي، 1405 هـ/1985م.
- الواقدي، محمّد بن عمر: المغازي، حقّقه مارسدن جونس، الأجزاء 3، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الأعلمي، 1409 هـ/1989م.
- يحيی بن معين: تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، حقّقه د. أحمد محمد نور سيف، الأجزاء 4، الطبعة الأولی، مکة المکرّمة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1399هـ/1979م.
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ: تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)، حقّقه د. أحمد محمد نور سيف، الأجزاء 1، دمشق، دار المأمون للتراث.